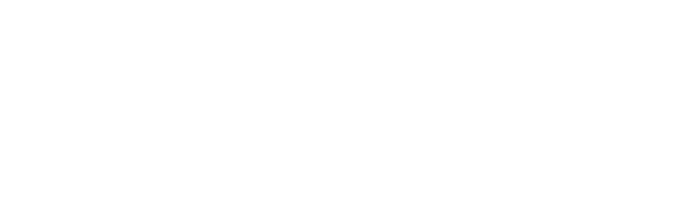الأزمة المالية العالمية: رؤية اشتراكية
يشهد الاقتصاد العالمي اليوم أكبر أزمة مالية منذ الكساد الكبير خلال الثلاثينات من القرن الماضي، ما هي الأسباب هذه الأزمة العنيفة؟ كيف بدأت؟ وكيف انتشرت من مركزها في قطاع التمويل العقاري الأمريكي لتشمل النظام الرأسمالي كله؟ هل ستتمكن الرأسمالية العالمية من الخروج من هذه الأزمة من خلال السياسات المطروحة الآن، من تدخل غير مسبوق للدولة وتقوية الأجهزة والإجراءات الرقابية على النظام المالي؟ كيف ستؤثر هذه الأزمة على الاقتصاد المصري، على معيشة ومستقبل الغالبية العظمى من سكان مصر، من العمال والفلاحين الفقراء؟ وماهي التحديات والفرص التي تطرحها هذه الأزمة وتوابعها، خلال الفترة القادمة أمام اليسار؟ وماذا علينا أن نفعل؟ ستحاول هذه الورقة طرح إجابات أولية علي هذه الأسئلة، التي يطرحها علينا هذا الواقع المأزوم.
(1)أسباب الأزمة:
يمكننا تقسيم النظام الرأس مالي إلى قسمين: القسم الأول هو رأس المال الإنتاجي-ويسمى أحيانا رأس المال الحقيقي-وهو رأس مال يتم استثماره في إنتاج السلع والخدمات، سواء الاستهلاكية، أو الإنتاجية، بهدف الربح، ومن خلال تشغيل واستغلال العمل المأجور، إذ يأتي الربح من خلال استخراج فائض القيمة، وهو الفارق بين ما يتم دفعه للعمال من أجور، وبين القيمة الحقيقية التي يخلقها هؤلاء العمال في العملية الإنتاجية، أما القسم الثاني من الرأسمالية فهو "رأس المال المالي"، وهو يتضمن البنوك التجارية والاستثمارية، والشركات التمويلية وسوق الأوراق المالية. المكون الرئيسي لهذا القسم هو البنوك التي تعتمد على إقراض الرأسماليين والأفراد والبنوك الأخرى، بمختلف تخصصاتها، مقابل الفائدة. وهناك علاقة عضوية بين رأس المال المالي ورأس المال الإنتاجي، فمالك المصنع مثلاً يحتاج إلى الاقتراض من البنك حتى يتمكن من شراء أدوات الإنتاج وقوة العمل، حتى تتم العملية الإنتاجية، ثم يتم بيع السلع المنتجة في السوق، وتحقيق الربح، والبنك لن يتمكن من تحقيق الفائدة، وهي السبب الوحيد لتقديم الائتمان، إلا إذا استثمر ذلك الائتمان بشكل منتج، وحقق الأرباح التي سيدفع منها المستثمر، قيمة ما اقترضه،بالإضافة إلى الفائدة.
ولكن مع توسع وتطور النظام الرأسمالي، تصبح العلاقة بين رأس المال المالي ورأس المال الإنتاجي أكثر تعقيدًا، فالبنوك على سبيل المثال، لا تستثمر أموالها فقط في إقراض الرأسمالي المنتج، بل تضخ الأموال في إقراض الأفراد(الرهن العقاري، وكروت الائتمان، مثلا)، وفي شراء الأسهم والسندات، في أسواق الأوراق المالية(البورصات).
وتصبح الشركات الرأسمالية الصناعية الكبرى، مع ازدياد حجمها، وتوسع إنتاجها وأسواقها على مستوى العالم، لاعبا أساسيًا في قطاع رأس المال المالي، فتخلق لنفسها أذرعا تمويلية، ويتم تداول أسهم شركاتها كأوراق مالية في البورصات، وتستثمر جزءًا متزايدا من فوائضها في أسواق المال.
ولكن يظل أساس النظام هو الإنتاج الرأسمالي للسلع، فمن هنا تأتي الأرباح، التي يتم تداولها في أسواق المال، ومن هنا تأتي الأجور، الدخول الحقيقية التي يتم بها شراء السلع والخدمات التي تنتجها الرأسمالية، فالمال لا يخلق نفسه، ورأس المال المالي، في حد ذاته، لا ينتج أي شيء على الإطلاق، فالبورصة على سبيل المثال هي سوق لأوراق مالية، تمثل في بدايتها قيمة الشركات التي تعبر عنها، ولكن مع بيع وشراء هذه الأسهم والمضاربة عليها، تبتعد قيمة الاسهم(الأوراق) عن القيمة الحقيقية للشركات أو السلع الحقيقية التي تمثلها، هبوطًا وصعودًا، طبقا للعرض والطلب عليها، وليس بالضرورة طبقًا لأصولها في العالم الحقيقي، وهذا "العالم الافتراضي"، والذي يسميه ماركس "رأس المال الافتراضي"، بأوراقه وأرقامه وإشاراته الإليكترونية على شاشات الكومبيوتر، يخلق ويدمر ثروات طائلة، في ثوان معدودة.
وكلما كانت معدلات الربح في القطاع الإنتاجي ضعيفة، تهرب الاستثمارات من مجال التوسع الإنتاجي، من مصانع وبنية تحتية..إلخ، وتتراكم في هذا القطاع المالي الافتراضي، وكلما تضخم هذا القطاع وكلما ابتعدت القيمة الافتراضية الورقية عن القيمة الحقيقية، أي عن قيمة الشركات بأدوات إنتاجها ومنشآتها، وأرباحها الإنتاجية، كلما أصبح النظام عرضة لأزمة مالية أكثر عنفا.
تعد الأزمة المالية الحالية، التي يعاني منها الاقتصاد الرأسمالي، تتويجاً لسلسلة من الأزمات التي عصفت بالرأسمالية العالمية، منذ مطلع السبعينيات من القرن العشرين، وهي بلا شك أخطر هذه الأزمات منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن نفسه.
ولكن جذور هذه الأزمات المالية لا تقع في القطاع المالي بل في قلب نمط الإنتاج الرأسمالى نفسه. فالإنتاج في الرأسمالية لا يتم من أجل تلبية حاجات البشر ولكن من أجل الربح. وهذه العملية تتم بشكل تنافسي بين الشركات الرأسمالية. كل شركة تحاول تعظيم أرباحها ونسبة مبيعاتها في الأسواق من خلال تكثيف استغلال عمالها ومن خلال توسيع وتطوير إنتاجها بالاستثمار في أدوات الإنتاج (بتطوير أو تغير الميكنة علي سبيل المثال)..وهذه الطبيعة التنافسية والاستغلالية للإنتاج الرأسمالي تؤدى إلي عدد من التناقضات الجوهرية. فأولاً كلما ازداد حجم الاستثمار في أدوات الإنتاج كلما تناقص الحجم النسبي لمصدر الربح الحقيقي وهو قوة العمل التي يتم استغلالها وهو ما يؤدي على المدى الطويل إلى ميل معدلات الربح للانخفاض. وثانياً تحتاج الشركات حتي تحصل علي أرباحها إلى أن تباع منتجاتها في السوق وإذا انخفضت القدرة الشرائية للعمال بفعل تكثيف استغلالهم فلن يتمكنوا من شراء تلك السلع وتكون النتيجة تراكم فائضاً للانتاج وهو ما يؤدي بدوره إلي تقليص الأرباح وتقليص شراء الرأسماليين للسلع الإنتاجية (المواد الخام والميكنة وغيرها من أدوات ومستلزمات الإنتاج). هذه التناقضات والتي لن ندخل في تفاصيلها في هذه الورقة القصيرة تؤدي ليس فقط إلي أزمات متتالية بل إلي البحث الدائم من قبل الرأسمالية عن مجالات للاستثمار تعوضها عن ضعف الأرباح في المجال الإنتاجي وهو ما شكل أحد الدوافع الرئيسية لتضخم القطاع المالي خلال العقود الثلاث الماضية.
(2)كيف تطورت الأزمة الحالية؟
يلعب سعر الفائدة، الذي يحدده البنك المركزي، دورًا رئيسيًا في تحديد سهولة ووفرة الائتمان في السوق الرأسمالي بشكل عام، فعندما يرفع البنك المركزي سعر الفائدة، يكون ذلك سببًا في عدم الاقتراض من البنوك، والإبقاء على الأموال فيها، والاستفادة من الفائدة العالية، وعندما يتم تخفيض سعر الفائدة يكون ذلك حافزًا للاقتراض والاستثمار في مشروعات مربحة. ولكن، إذا انخفضت أسعار الفائدة، ولم يكن هناك مجالاً إنتاجيًا مربحًا، فيتم توظيف القروض في مجالات غير إنتاجية، مثل سوق الأوراق المالية، وشراء العقارات، وغيرها. وهذا بالضبط ما حدث مع الاقتصاد الأمريكي، في مطلع القرن الواحد والعشرين، فقد واجه البنك المركزي الأمريكي الكساد النسبي، الذي عانى منه الاقتصاد الأمريكي في ذلك الحين، والذي ازداد عمقاً منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001، عن طريق تخفيض سريع لسعر الفائدة، من أجل تشجيع الاستثمار المنكمش.
أصبح الاقتراض السهل هو عنوان المرحلة، وتسابقت البنوك والصناديق التمويلية للاستفادة من تلك الأموال"السهلة"، وكان أحد المجالات الرئيسية لاستثمار تلك الأموال هو قروض الرهن العقاري للأفراد، وكانت هناك تسهيلات غير مسبوقة، في شروط وضمانات هذه القروض، وهي نتيجة منطقية، ليس فقط لما يتصوره البعض لفقدان الراقابة والضوابط، ولكن أيضًا، وهو الأهم، نتيجة للسيولة المالية التي أحدثها تخفيض سعر الفائدة، مع تضاؤل ربحية المشروعات الإنتاجية.
ملايين العائلات الأمريكية شرعت في شراء العقارات، من خلال قروض الرهن العقاري، مما زاد بشكل جنوني من أسعار العقارات في السوق الأمريكي(بنسبة تصل من200% خلال الفترة2001: 2006) وهو ما أدى بدوره إلى زيادة جاذبية هذا القطاع للاستثمارات المالية من قبل البنوك. كان مركز قروض الرهن العقاري، هو البنوك المتخصصة في هذا المجال، مثل العملاقين الامريكيين "فريدي ماك" و"فاني ماي"، أكبر شركتين في هذا المجال على مستوى العالم.
ولكن، وبسبب سياسات التحرير الاقتصادي، خاصة في المجال المالي، وعولمة المنظومة المالية الرأسمالية، تطورت أسواقًا لتداول أوراق الرهن العقاري، شملت البنوك والشركات المالية، ليس في السوق الأمريكية وحدها بل على مستوى العالم، واكتظت خزائن هذه البنوك والشركات بتلك الأوراق الممثلة للرهون العقارية، فيما يُطلق عليه الاقتصاديون ظاهرة "التوريق"، وهو ما أدى إلى خلق فقاعة "افتراضية" لقيم العقارات الأمريكية(وكذلك في اسبانيا وأيرلندا، وغيرها...)، فالقيمة الورقية للعقارات أبتعدت تماما عن القيمة الحقيقية لتلك العقارات، وقيمة الأوراق الممثلة للرهون العقارية، أخذت أيضًا تتباعد عن القدرة الحقيقية للمقترضين الأصليين على تسديد الأقساط وفوائدها. سرعان ما اصطدم "الافتراض" بـ"الواقع"، فتوقف عدد من المقترضن عن سداد الأقساط، ومن ثم بدأت البنوك العقارية في الحجز على العقارات، وطرد سكانها، مما تسبب في حالة من الذعر في القطاع المالي بأكمله، فلم يعد أحد يعرف بالضبط، ما هي نسبة القروض"السيئة"، التي لن يتم سداد قيمتها، ولا درجة انتشار تلك الأوراق، التي تم تداولها في القطاع المصرفي بوجه عام.
كانت بداية الانهيار في إفلاس بنك"بير ستيرنز" العريق، والذي اتضح أنه كان غارقا في تلك الأوراق "السيئة" في صيف ٢٠٠٧. ومع انشار حالة الذعر بدأت أسعار العقارات في انخفاض سريع. وأصبح الكثير من المقترضين مدينين للبنوك بأكثر من قيمة العقارات التي يدفعون أقساطها، مما زاد من تعقيد الأزمة.
بلغت الأزمة ذروتها في مطلع شهر سبتمبر2008، حينما أوشك العملاقين"فريدي ماك" و"فاني ماي"، على الانهيار، وتدخلت الحكومة الأمريكية لتأميم الشركتين على الفور، رغم ثلاثون عاما من الدعاية الإيديولوجية عن حرية السوق"، وضرورة عدم تدخل الدولة في الاقتصاد.
وفي منتصف سبتمبر افلس بنك "ليمان برازرز" العريق، الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر، لكن الحكومة لم تتدخل لإنقاذ البنك، معبرة عن حالة من التذبذب وعدم ضوح الرؤية، والتي سرعان ما انعكست في مزيد من الذعر في الأسواق، وشهدت بورصة نيويورك، وغيرها من البورصات العالمية موجات متتابعة من الانهيار. وتلى ذلك على الفور قيام الحكومة الأمريكية بضخ85مليار دولار لشراء أسهم أكبر شركة تأمين في العالم(آي.آي.جي)والتي كانت هي الأخرى على وشك إشهار إفلاسها. لكن، حتى هذا الإجراء، غير المسبوق، منذ ثلاثينيات القرن الماضي، لم ينجح في تهدئة حالة الذعر في الاسواق، وظلت البورصات العالمية تشهد انهيارات غير مسبوقة، فانتقلت الازمة سريعا من النظام المالي الأمريكي إلى النظام المالي العالمي.
انتشرت الازمة مثل النار في الهشيم، لتشمل البنوك والشركات التمويلية والبورصات في أوروبا وآسيا، وكافة المراكز الرأسمالية الكبرى. فمن جانب ، وبسبب سياسات العولمة وتحرير الأسواق، انتقلت الكثير من تلك الأوراق "المسمومة" من البنوك الأمريكية إلى البنوك الأوروبية والآسيوية، وآخذت البنوك، الواحد تلو الآخر، في إشهار إفلاسها، وقامت الحكومات بدورها، الواحدة تلو الأخرى، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بتأميم البنوك أو شراء الأسهم، وضخ المليارات في سوق المال، ولكن ظل الذعر مسيطرًا على الأسواق، وأصاب الشلل النظام البنكي سواء في أمريكا، أو في المراكز المالية الأخرى، ولعل أهم مؤشر على ذلك هو امتناع البنوك الاستثمارية عن إقراض بعضها البعض، فلا أحد يعرف من سيُفلس قبل الآخر، وما مدى امتلاء خزانة كل منهم بتلك الأوراق "المسمومة".
كان هناك عاملاً آخر لتفاقم آثار الأزمة، ألا وهو الخلل الكبير منذ نهاية التسعينات بين المدخرات في الأسواق الناشئة مثل الصين ودول الخليج، وبين العجز المتزايد في ميزان مدفوعات الاقتصاد الأمريكي، فدول مثل الصين شهدت طفرة كبيرة في التصنيع التصديري، وكانت الولايات المتحدة هي المستورد الأكبر لتلك الصادرات، في المقابل، كان الفائض الصيني يتم إدخاره بالدولار، كما كان يتم استثمار جزء كبير منه في البنوك وسندات الخزانة الامريكية، وهو ما أدّى بدوره إلى توسُّع غير مسبوق في دائرة الإقراض للمستهلكين الأمريكيين.
وهكذا، أصبح المستهلك الأمريكي قادرا على شراء الصادرات الصناعية الصينية، ليس من خلال الدخل الحقيقي لهؤلاء المستهلكين، ولكن بالاقتراض من البنوك، عن طريق كروت الائتمان. وكما في حالة العقارات، أصبح المستهلك الأمريكي يعيش بالدَيْن، وأصبح مستوى معيشته، والسلع التي يستهلكها، ليس انعكاسا للزيادة في دخله، ولكن لسهولة الاقتراض من البنوك. فالصين تصدر سلع لأمريكا، والمستهلك الأمريكي يقترض لشراءها، ثم يُضَخ الفائض الذي تراكمه الصين في البنوك وسوق المال الأمريكيين، مما يؤدي إلى المزيد من الإقراض للمستهلك الأمريكي، وبالتالي شراء المزيد من السلع الصينية. وهكذا، نشأت تلك الدائرة الجهنمية وتوسعت، وهذا الخلل أنتج بدوره المزيد من الهشاشة في النظام المالي العالمي. مع أزمة البنوك الأمريكية والأوروبية، وعدم قدرتها على الإقراض، تتضائل قدرة المستهلك الأمريكي والأوروبي على الشراء، وبالتالي يؤثر ذلك سلبًا على اقتصاد البلدان المُصدّره، مثل الصين.
(3)تأثيرات الأزمة:
أ-الدول الصناعية الكبرى:
لقد طرحنا فيما سبق أن الأزمة الحالية قد بدأت وانتشرت في القطاع المالي، وسرعان ما انتقلت، كما هو متوقع، إلى بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الإنتاجي، فالانكماش في قدرة البنوك على الإقراض، يعني انكماشا في مصادر تمويل الشركات الصناعية والإنتاجية، فهي تحتاج بشكل دائم إلى سيولة ائتمانية، لتغطية مصروفاتها، وللإنفاق على تطوير وتوسيع إنتاجها، ويؤدي ذلك الانكماش بالضروروة، إلى تقليص الأنشطة، في حالة الشركات الكبرى-إغلاق مصانع أو وقف مشروعات التوسع- وإلى إفلاس الشركات الأصغر، غير القادرة على مواجهة العاصفة المالية، وهو ما يؤدي بدوره، إلى زيادة مطّردة في حجم البطالة، حيث تتخلص الشركات من العمالة لتقليص الإنفاق.
وتؤدي الزيادة في البطالة، بالطبع، إلى انخفاض حاد في القدرة الشرائية، وبالتالي، في استهلاك السلع التي تنتجها الشركات. والشركات، بالطبع، لا يمكنها أن تستمر في الإنتاج، إن لم تضمن وجود من يشتري منتجاتها، وقد أعلنت كبرى الشركات الصناعية، في مجالات صناعة السيارات والإلكترونيات والحديد والأسمنت عن خسائر كبرى في الربع الثالث من عام 2008، مع توقعات بمزيد من الخسائر في الفترة القادمة، وهذا بدوره لن يؤدي إلا إلى المزيد من البطالة، وانخفاض في القدرة الشرائية للمستهلكين.
وكما هي العادة في كل الأزمات الرأسمالية، فالعمال والفقراء هم من يتحملون العبء الأكبر من تبعات الأزمة، فالعامل الأمريكي أو الأوروبي يفقد بيته لأنه غير قادر على دفع أقساط الرهن العقاري، ويفقد القدرة على الاقتراض من البنوك التجارية، وفي النهاية يفقد وظيفته لينضم إلى جيش العاطلين.
ب-الدول النامية
تبنت حكومات غالبية الدول النامية خلال العقدين الماضيين السياسات الاقتصادية المعروفة بإسم "الليبرالية الجديدة"، بهدف ربط اقتصاداتها بالمراكز الرأسمالية الكبرى، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والإنتاج التصديري وتحرير السوق من خلال الخصخصة وتحرير أسواق السلع والعقارات والخدمات وتقليص دور الدولة في الاقتصاد بشكل عام. كانت نتيجة تلك السياسات الكارثية، كما نعرف، عملية نهب منظم لحقوق ومكتسبات الأغلبية من السكان، من العمال والفلاحين الفقراء، لصالح كبار المستثمرين المحليين والشركات متعددة الجنسيات.
كانت إحدى النتائج الأخرى الرئيسية لتلك السياسات هي إدماج اقتصاد غالبية الدول النامية في المنظومة المالية والاقتصادية العالمية، وبالتالي تعريضها بشكل دائم لتقلبات وأزمات، وفوضى تلك المنظومة. وكما رأينا في أزمة1997-1998، التي بدأت في جنوب شرق آسيا ، وامتدت إلى روسيا والبرازيل، وغيرها من "الأسواق الناشئة"، فالاستثمارات الأجنبية تنسحب بسرعة البرق من تلك الأسواق عند أول إشارة للأزمة، وسرعان ما تتعرض عملات وبورصات تلك الدول للانهيار بفعل مزيج من الذعر والمضاربة من قبل كبار المستثمرين، واعتماد تلك الدول على التصدير يفترض استقرار الاستهلاك والنمو في الدول الرأس مالية الكبرى، ويفترض أيضا القدرة على توجيه الاستثمارات الصناعية نحو إنتاج السلع التي يزداد عليها الطلب في السوق العالمية، في ظل منافسة شرسة بين الدول النامية، التي ينتج الكثير منها السلع نفسها. هذه الافتراضات سرعان ما ينكشف قصورها في ظل الفوضى السوق الرأسمالي العالمي، وهكذا رأينا في1997-1998 موجة من الانهيارات في جنوب شرق آسيا كان أعنفها في إندونيسيا، التي وصلت نسبة البطالة فيها إلى40%، وانهارت عملتها وبورصتها، وآثار الأزمة رغم ضراوتها، ورغم الجوع والفقر والتشريد التي تسببت فيها، تعتبر محدودة للغاية، إذا قارناها بما نواجهه اليوم، فقد تركزت تلك الأزمة في مناطق بعينها، وكان تأثيرها محدودًا في كبرى مراكز التركز الرأس مالي العالمي. لكن الأزمة هذه المرة قد أصابت قلب النظام الرأس مالي نفسه، ولن ينجو أحد من تبعاتها.
لقد بدأت آثار الأزمة العالمية بالفعل على اقتصاد الدول النامية، حتى أقواها، وهي الصين، فرأس المال الأجنبي، أي الشركات متعددة الجنسيات، قامت بعملية هروب كبير من الأسواق الناشئة، وازدادت مؤشرات انهيار البورصات، فحتى بورصة شنغهاي الصينية فقدت أكثر من 50% من قيمتها في الشهور الثماني الأولى من عام2008، وتم سحب ما يقرب من80مليار دولار من الأسواق الناشئة بين يونيو وسبتمبر الماضيين، وقد قدرت مؤسسة "مورجان ستانلي" المالية أن التدفقات المالية إلى الدول النامية ستنخفض خلال 2009، بما يتجاوز200مليار دولار بما سيزيد من العجز في ميزان المدفوعات لأكثر من 80دولة في العالم الثالث.
إلى جانب الهروب الكبير للاستثمارات الأجنبية، هناك الانكماش الأكبر لصادرات دول العالم الثالث، والتي تعتمد معظمها على أسواق الدول الرأسمالية الكبرى، وقد رأينا ما يحدث للمستهلك الأمريكي على سبيل المثال، بكل ما سينتج عنه من إفلاس وإغلاق للمصانع، وزيادة سريعة في نسبة البطالة والفقر والتشريد.
لقد عانى فقراء العالم الثالث، طوال العامين الماضيين، من تضخم غير مسبوق في أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام، وأحد الآثار المباشرة للركود العالمي الحالي هو انخفاض حاد في أسعار تلك السلع، بسبب الانخفاض السريع للطلب العالمي، لكن فقراء العالم الثالث لن يستفيدوا كثيرًا من تلك الانخفاضات في الأسعار، لماذا؟ أولا لأن انخفاض أسعار السلع الأساسية لا ينعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية، فالمستفيد الأول منها سيكون كبار محتكري تلك السلع في بلدان العالم الثالث، وثانيا لأن البطالة وانخفاض الأجور الحقيقية سيكون أسرع وأكبر، بفعل الأزمة، من الانخفاض في الأسعار، فالعامل العاطل والفلاح المعدم لن يستفيد من انخفاض محدود في أسعار السلع. وثالثا لأن أحد التأثيرات الهامة للأزمة الحالية سيكون انهيار قيمة عملات كثير من الدول، فقد انخفضت قيمة عملات البرازيل والمجر وأوكرانيا وإندونيسا بنسب تتراوح بين20%:50%، والبقية تأتي. يعني ذلك تضخما في أسعار السلع الأساسية التي تستوردها بلدان العالم الثالث. رابعًا، لأن الكثير من تلك الدول تعتمد على تصدير السلع الغذائية والمواد الخام، وبالتالي فإن انهيار اسعارها سيؤدي إلى انهيار قيمة صادراتها، وما له من تأثير مدمر على فقراء الفلاحين.
(4)الحلول المطروحة للأزمة:
هيمنت خلال العقود الثلاث الماضية أفكار وسياسات حرية السوق الليبرالية الجديدة على الغالبية العظمى من حكومات العالم، وجوهر هذه الرؤية هو ضرورة تقليص دور الدولة في الاقتصاد، من خلال الخصخصة و"تحرير الأسواق" في كافة القطاعات المالية والصناعية والخدمية، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية والتأمينات. وقد رأينا خلال الأزمة الحالية كيف اضطرت حكومات الدول المتقدمة، وعلى رأسها الحكومة الأمريكية أن تتبنى سياسات تتناقض كليًا مع ما ظلت تطرحه في دعاياتها، وفي السياسيات التي تفرضها عن طريق البنك وصندوق النقد الدوليين على مختلف بلدان العالم.
نحن نشهد، خلال هذه الأزمة، أكبر تدخل حكومي في الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية، فالبنوك المركزية تنفق الترليونات في تأميم كبرى البنوك العالمية وشركات التأمين، وفي شراء الأسهم والأوراق المالية "المسمومة" وهذا كله في محاولة محمومة لإنقاذ النظام من حالة الشلل المالي التام، ومن الانزلاق في كساد كبير، يتجاوز حجمه وتأثيره كساد الثلاثينات من القرن العشرين.
تطرح هذه السياسات الجديدة تحولاً، حتى وإن كان مؤقتا في فلسفة "السوق الحر" الليبرالية الجديدة ،إلى واقع رأس مالية الدولة والتأميم، وهو تحول يخلق شرخً ضخما في الهيمنة الفكرية البرجوازية بمؤسساتها الإعلامية، وجامعاتها، وصانعي سياساتها الاقتصادية. وإذا نحينا جانبا تلك الأزمة الفكرية التي تخلقها هذا التحول الحاد في السياسات، فإنه يبقى السؤال المُلِح، والمباشر: هل ستتمكن الحكومات من إنقاذ النظام من خلال هذه السياسات؟.
أول ما يجب طرحه في الرد على هذا السؤال هو أن علينا أن نتوخى الحذر الشديد بشأن التنبؤات حل مصير الاقتصاد العالمي، فالمتغيرات والعوامل متعددة ومعقدة، ولا يمكن التكهن بدقة حول احتمالات تفاعل وتطور هذه المتغيرات والعوامل.
على المدى القريب، يبدو حتى وقت كتابة هذه السطور(نهاية أكتوبر2008) أن التدخل الحكومي غير المسبوق في سوق المال والبنوك، وعلى رأسها الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، قد مكنهم من تفادي الانزلاق في كساد عالمي كبير وفي شلل كامل لسوق المال العالمي. لكن هذه السياسات التدخلية لم ولن تنقذ الرأسمالية من الدخول في ركود عالمي عميق خلال العامين القادمين.
كانت تقديرات صندوق النقد الدولي تشير، في منتصف سبتمبر، إلى أن اقتصاد الدول الرأسمالية الكبرى لن يتجاوز0.5%خلال عام2009، وهو ما يعني عمليًا انكماشًا حادًا في تلك الاقتصادات، وتشير التقديرات نفسها إلى أن الاقتصاد العالمي ككل لن يتجاوز نموه 3% خلال العام القادم، فقد تراجع نمو الاقتصاد الصيني من أكثر من12%إلى أقل من 9%خلال2008، وبالطبع يكون أثر الركود العالمي أكبر وأخطر على اقتصاد الدول الأضعف، فدول مثل باكستان وتركيا والمجر والبرازيل والأرجنتين، وإندونيسيا على رأس الاقتصادات المهددة بالانهيار، وهذه هي مجرد بداية.
ولكن وعلى المدى الأطول فهناك عدد من العوامل التي يمكنها أن تجعل من الركود العالمي الحالي مجرد مقدمة لأزمات أكثر حدة في النظام الرأسمالي العالمي. أول هذه العوامل أن البنوك المركزية التي تضخ آلاف التريليونات اليوم، يجب ان تأتي بهذه التريليونات من مكان ما، والمصدر الرئيسي للمال الحكومي هو الضرائب، وهو ما يعني أن الأموال التي يتم ضخها اليوم هي حصيلة الضرائب في المستقبل، وبالطبع من سيدفع الثمن هم الغالبية العظمى من دافعي الضرائب وهم العمال والموظفون. ولكنه أيضًا يمثل رهانًا غير مضمون، إذ يقوم على افتراض أن الاقتصاد سيتعافى للدرجة التي تمكن الدولة من تحصيل الضرائب اللازمة لدفع الفاتورة المهولة للأزمة!. وبالطبع يمكن للدول أن تطبع الأموال، لكن ذلك يعني الدخول في حالة تضخم خطيرة.
العامل الثاني هو أن الحجم النسبي للبنوك المركزية وما تستطيع توفيره من اموال قد تضائل بسبب النمو غير المسبوق للشركات الاحتكارية العملاقة ، متعددة الجنسيات، وهو ما يعني أن قدرة البنوك المركزية في إنقاذ مثل هذه الشركات العملاقة يصبح موضع شك.
العامل الثالث هو أن التداخل والاندماج في الاقتصاد الرأس مالي العالمي يصعبان بشدة من مهمة البنوك المركزية، فالأمر يحتاج إلى درجة من التنسيق والوحدة بين البنوك المركزية، يصعب تحقيقها في عالم قائم على التنافس، ليس فقط بين الشركات، ولكن أيضًا بين الدول الرأسمالية المختلفة. ويجدر هنا الإشارة إلى ما حدث في اليابان في تسعينات القرن العشرين، حين دخل الاقتصاد الياباني في حالة ركود طويلة، فقام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، من أجل تنشيط الاقتصاد في حين كان سعر الفائدة في أوروبا وكثير من الأسوق الناشئة يتجاوز 4%. كانت إحدى نتائج ذلك هي قيام المستثمرين بالاقتراض من بنوك اليابان، وإيداع الأموال في بنوك الدول ذات سعر الفائدة الأعلى، وبالتالي من تحقيق ربح صافي من الفارق بين أسعار الفائدة، بمجرد تحويل الأموال من بلد إلى أخرى.
من كل ما سبق، يمكننا القول أنه ربما يكون الاقتصاد العالمي قد تفادى كسادًا كبيرًا، ولكن، رغم كل الأموال التي تُضَخ فإنه لم يتمكن من تفادي ركود عالمي عميق، وأنه على المدى البعيد، لن يتمكن من الإفلات من أزمات أعنف ومن زلازل أكثر تدميرًا.
5 الحل الرقابي والحل الإسلامي
تمتليء الساحة بالكثير من التفسيرات للازمة الحالية ولوسيلة الخروج منها، لعل أكثرها سذاجة هي تلك القائلة بأن المشكلات تكمن في غياب الرقابة الكافية على القطاع المالي فحسب. أي أن الأجهزة الرقابية لم تلعب دورًا كافيًا في الحد من المضاربة في الأوراق المالية ومراقبة شروط وضمانات القروض التي تقدمها البنوك، وعلى المستوى السطحي لا خلاف حول تخفيف دور الأجهزة الرقابية خلال العقد الماضي، لكن مشكلة ذلك التفسير هو أنه يخلط بين النتيجة والسبب، فكما حاولنا أن نبين في الجزء الأول من هذه الورقة، أن سياسة البنك المركزي الأمريكي خلال العقد الماضي، وخاصة بعد أزمة 2001، كانت في جوهرها محاولة خلق سيولة مالية، من خلال تخفيض سعر الفائدة، وضخ الأموال وتوسيع دائرة الاقتراض، بحيث تنقذ الاستهلاك الأمريكي من الانكماش، وهو ما نتج عنه تجاوز البنوك والشركات المالية لقواعد الرقابية، وليس العكس.
وهناك تفسيراً آخراً لا يقل سذاجة وهو ما سمي بالتفسير الإسلامي. وقد أعد د.عبد الحميد الغزالي، القيادي الإخواني، بناءًا على تكليف من المرشد العام، ورقة يقدم فيها تفسيرًا للأزمة وسبل الخروج منها، وفقا لروية إسلامية. لا يخرج الجزء الأكبر من الورقة عن التفسير السطحي الذي يطرحه الاقتصاديون البرجوازيون في الصحف والفضائيات، الا وهو أن الأزمة ليست في التناقضات الجوهرية في النظام الرأسمالي، فالمشكلة كما يصورها د..الغزالي هي غياب أو تغييب الرقابة على منظومة الإقراض، وفي أسواق الأوراق المالية، وجشع المنتفعين بها. لكن ما يميز الورقة هو الحل الذي تطرحه للأزمة، فهو يدعو إلى "التفكير الجاد في دراسة تطبيق النظام الإسلامي البعيد عن سعر الفائدة "الربوي"، والقائم على معدل الربح كآداة فعالة لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر، والذي يستند إلى القيام باستثمار حقيقي لتوسيع القاعدة الإنتاجية، وليس على أساس استثمار مالي قوامه المضاربات، أو المقامرة أو الاستغلال أو الفساد...."
فالمشكلة، وفقا "للمنظور الإسلامي" المطروح ليست في الربح الرأسمالي، الذي يأتي من استغلال العمال ونهب فائض قيمة عملهم، بل في الإقراض بالفائدة أو "الربا"، أي أن الأرباح الرأسمالية التي تأتي مما يسميه الاستثمار الحقيقي "حلال"، أما الإقراض بالفائدة فهو "حرام". ونحن لا نرمي إلى الخوض في المسائل الفقهية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، ولكننا نشير إلى التناقض الصارخ في "الطرح الإسلامي" بين الرغبة في الإبقاء على منظومة الربح الرأسمالي، القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، واستغلال العمال، وفوضى السوق وبين الرغبة في القضاء على أحد الأعمدة الرئيسية لهذه المنظومة، وهو النظام البنكي القائم على الفائدة. لقد طرحنا في بداية هذه الورقة كيف أن البنوك(رأس المال الحامل للفائدة)، والرأسمالية الإنتاجية(رأس المال الحامل للربح) هما في الواقع وجهان لعملة واحدة. فالأول لا يمكنه البقاء إلا على أساس وجود أرباح "حقيقية" من إنتاج "حقيقي"، والثاني لا يمكنه البقاء إلا على أساسا وجود نظام مالي مستقل نسبيًا، يمنحه السيولة والمرونة المالية التي يحتاجها لتغطية نفقاته، خاصة في الفترة الزمنية بين البدء في عملية الإنتاج، وبين لحظة تحقيق الربح في السوق، أما الفائدة فهي الثمن الذي تفرضه البنوك مقابل تقديم تلك الخدمة.
فنحن، إذًا، لا يمكننا في الواقع، وبالاستدلال المنطقي، أن نفصل بين الربح الرأسمالي وبين الفائدة، أو "الربا" التي يصفها الغزالي ، في نهاية ورقته، بقولة "كبيرة الربا وراء كل الشرور الاقتصادية التي تعاني منها البشرية"، وهو بالتالي يبريء عملية الاستغلال الرأسمالي من هذه "الشرور"، ويرى أنها "حلال".
كان "الربا" قديمًا، ولا تزال "الفائدة" في العصر الرأسمالي الحديث، كارثة فعلية تعاني منها البشرية، ولكنها جزء لا يتجزأ من النظام الرأسمالي القائم على الربح، ومن يريد حقًا أن يقضي على آفة "الربا" عليه أن يقضي على منبعها، وسبب وجودها الحقيقي، وهو النظام الرأسمالي نفسه، وإلا فإن أطروحته تصبح، ليست ساذجة وغير منطقية فحسب، بل أيضا داعمة ومبررة للرأسمالية بكل شرورها.
(6)مصر والازمة العالمية:
من يتابع تصريحات وزراء حكومة نظيف حول الازمة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، لا يمكنه إلا أن يشعر ببعض الشفقة وكثير من الغثيان. فهناك، أولا تخبط وتضارب في التصريحات من يوم لآخر ومن وزير لآخر، فمع بداية الازمة أعلن محمود محي الدين، وزير الاستثمار، أن مصر لن تتأثر بالأزمة كثيرًا، بل يمكنهاالاستفادة منها!. ومع التناقض الشديد بين هذلية هذه التصريحات وبين واقع انهيار البورصة، وانخفاض قيمة الجنية، بدأ الحديث عن احتمال انخفاض معدل النمو المزعوم من7: 6%، وتنوعت تقديرات الانخفاض بين وزير وآخر في الحكومة نفسها. وهم معذورون في هذه الحالة من التخبط والهذيان، فهم ملكيون أكثر من الملك، وعندما يرون الصنم الذي يعبدونه-اقتصاد السوق الحر والعولمة-ينهار أمام أعينهم، وعندما يرون نفس الحكومات والمؤسسات العالمية الكبرى يقومون بتأميم أكبر البنوك الخاصة، في وقت يتباهى فيه وزرائنا ببيع بنوك القطاع العام، لنفس تلك البنوك العالمية المنهارة. عندما يرون كل ذلك، وهم مجرد ببغاوات يرددون ما ظلوا يسمعونه في واشنطن طوال العقود الثلاث الماضية، فمن الطبيعي أن يتخبطوا في تصريحاتهم وفي سياساتهم.
لكن!، ما هو التأثير الحقيقي للأزمة الحالية على الاقتصاد المصري، بعيدًا عن مهاترات المسئولين والاقتصاديين في حكومة رجال الاعمال المصرية؟، وعلاما يعتمد هذا الاقتصاد اليوم؟ يمكننا تحديد عدد من المحاور الاساسية وهي الاستثمار الاجنبي والسياحة، وقناة السويس، والتصدير، والطفرة في سوق العقارات.
بالنسبة للاستثمار الأجنبين فقد رأينا كيف يحدث اليوم هروبًا كبيرًا لاستثمارات الشركات العالمية من أسواق الدول النامية، بما فيها أقوى تلك الأسواق(البرازيل والمكسيك والمجر والهند...) وقد رأينا أول تأثيرات ذلك في البورصة المصرية، والتي فقدت أكثر من50%من قيمة أسهمها خلال الشهور الستة الماضية. الأمر نفسه ينطبق على الاستثمارات العقارية والإنتاجية، التي وصلت خلال العام 2007/2008 إلى 11مليار دولار، فأول ما يهتز عندما يتعرض النظام الرأسمالي لأزمة عنيفة هو ثقة المستثمرين في "الأسواق الناشئة" فيقومون بسحب ما يستطيعون من رؤوس أموالهم من تلك الأسواق، وإلغاء كافة خطط التوسع في تلك الأسواق، وتقليص تواجدهم فيها إلى حدّه الأدنى. فمن المتوقع إذا أن تنكمش الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال العامين القادمين.
أما السياحة فيمثل دخلها أكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي المصري، وحوالي 20% من مصادر النقد الأجنبي. وقد وصل عدد السياح في 2007/2008إلى حوالي 10ملايين سائح، ويشتغل بقطاع السياحة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، اكثر من مليون عامل وموظف. وتأتي الغالبية العظمى من السياحة في مصر من أوروبا وامريكا وروسيا واليابان ودول الخليج. وقد رأينا كيف ينكمش استهلاك المواطنين في الدول الرأسمالية الكبرى سريعا، ورأينا كيف يفقدون بيوتهم ومدخراتهم ووظائفهم، ومن لم تطاله العاصفة بعد، فهو سيقلص نفقاته إلى الحد الأدنى خوفا من القادم. وهو ما يعني أن السياحة الوافدة من تلك البلدان سوف تشهد انكماشًا شديدًا في الفترة القادمة. ووضع السياحة الخليجية ليس أفضل كثيرًا فسعر برميل البترول فقد أكثر من نصف قيمته، حيث هبط من140دولار إلى أقل من70دولار للبرميل، وذلك خلال أسابيع، هذا إلى جانب المليارات التي خسرتها دول الخليج النفطية من استثماراتهم في بورصات وأسواق المال الأمريكية والأوروبية. وعلى ذلك، سيكون هناك انخفاضًا حادًا في دخل قطاع السياحة، والقطاعات المرتبطة به.
أما قناة السويس وقد وصلت عائداتها في 2007/2008إلى أكثر من 3.5مليار دولار فهي أيضًا ستتأثر تأثُرًا كبيرًا بسبب الأزمة العالمية، حيث تعتمد عوائدها على حجم حركة شاحنات السلع التي تمر بها، وبما أن هناك انكماشا حادًا في حجم التجارة العالمية، بما فيها البترول، فسوف تشهد الفترة القادمة، بالضرورة، تقلُّصا حادًا في عائدات قناة السويس، وهي المصدر التالي، بعد السياحة، للنقد الأجنبي في مصر.
أما عن الصادرات، فلن تتمكن هي الأخرى من تفادي العاصفة، فالجزء الأكبر من قيمة هذه الصادرات تأتي من تصدير البترول والغاز الطبيعي والتي شهدت أسعارها انخفاضاً حاداً، ولكن حتى الصادرات غير البترولية ستنكمش، بالضرورة، مع انكماش الاستهلاك في الدول المستورِدة الأساسية، وهي أمريكا والاتحاد الأوروبي، ليس بفعل انكماش الطلب فحسب، بل أيضا بسبب المنافسة المحمومة بين دول العام الثالث على هذه الاسواق المنكمشة.
سنواجه إذًا في الفترة القادمة تقلُّصا حادًا في الدخل من الاستثمار الأجنبي والسياحة وقناة السويس والتصدير، وهي كلها مصادر رئيسية للنقد الأجنبي، وذلك في دولة تستورد ما تصل قيمته إلى ضعف قيمة ما تُصدره. أولى النتائج ستكون انخفاضًا حادًا في قيمة الجنيه، الذي فقد بالفعل10%من قيمته أمام الدولار خلال الشهر الماضي، وهو ما يعني أن أسعار السلع الأساسية، وأغلبها يتم استيراده، سوف يرتفع مجددًا، بالرغم من الانخفاض في الأسعار العالمية. وانخفاض قيمة الجنيه يعني أيضًا المزيد من فقدان الثقة لدى المستثمرين المصريين والأجانب في صحة الاقتصاد بشكل عام، وفي استثماراتهم بالجنيه المصري بشكل خاص، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من الضغط على قيمة الجنيه. وهو ما يعني أن التضخم السريع الذي عانينا منه خلال العام الماضي، والذي يصل إلى25%على اقل تقدير، لن يتراجع خلال الفترة القادمة، رغم تأكيدات وتصريحات المسئولين.
النتيجة الثانية لهذه العاصفة ستكون بلا شك زيادة مطّردة في حجم البطالة واتساعها وفي المزيد من الضغط على الأجور. فالرأسمالي الذي لن يتمكن من تحمل العاصفة سيعلن إفلاسه، ويغلق مصانعه وشركاته، ويشرد العاملين بها، والرأسمالي الذي سيتمكن من البقاء، سيقلص من عمال وموظفين شركاته للحد الأدنى، وسيخفض من أجور ومستحقات من يبقيهم إلى الحد الأدنى أيضاً.
تبقى نقطة أخيرة حول قطاع العقارات والذي شهد طفرة غير مسبوقة في الأعوام الأربعة الماضية . ولنضع جانباً الآن غرق هذا القطاع في بحر من فساد السلطة واحتكارات رجالها وكون غالبية مشاريعها موجهة فقط لإسكان وترف الأغنياء في بلد يعيش غالبية سكان مدنه في عشوائيات غير آدمية، ولنركز الآن على كيف سيتأثر هذا القطاع المتضخم بالأزمة العالمية، وكيف سيؤثر ما سيحدث في هذا القطاع على الاقتصاد المصري.
تمثل الطفرة العقارية والزيادة الفلكية في أسعار العقارات نموذجاً آخراً للفقاعات الاقتصادية التي دائمًا ما تخلفها فوضى النظام الرأسمالي. وهذه الفقاعة بخلاف فقاعة سوق العقارات الأمريكية مثلاً ليست نتيجة لتفشي الرهن العقاري والمضاربة على أوراقه (الرهن العقاري في مصر يمثل نسبة ضئيلة من قيمة هذا القطاع في مصر). إن سبب الفقاعة العقارية المصرية يكمن في دخول شركات تنمية عقارية كبرى خليجية ومصرية باستثمارات ضخمة لانشاء مشروعات عقارية عملاقة ( الفطيم وداماك وإعمار من الخليج وطلعت مصطفى وسوديك وبالم هيلز من مصر). كل هذه الشركات حصلت على تسهيلات استثنائية من الحكومة (أسعار أراض تكاد تكون مجانية، إعفاءات ضريبية،... إلخ) وقد ضخت هذه الشركات وغيرها المليارات لبناء مشاريع الإسكان الفاخر حول القاهرة والجيزة وسواحل البحر المتوسط والأحمر. وفي ظل زيادة أسعار العقار أصبح هذا المجال مرتعاً للمضاربين المصريين والأجانب الذين قاموا بشراء الآلاف من هذه العقارات، التي لم يتم إنشاء الكثير منها بعد، ليس بهدف السكن، بالطبع، ولكن للرهان على استمرار ارتفاعها مستقبلاً من أجل بيعها وجني الأرباح.
توشك هذه الفقاعة على الانفجار، فالطلب والاستثمار الخليجي سينكمش بفعل الازمة وانهيار أسعار البترول، وسوف يتسابق المضاربون لبيع عقاراتهم، خوفاً من انهيار الأسعار وستفاجىء شركات التنمية العقارية الكبرى بمشروعاتها تتحول إلى مدن للأشباح، فحجم هذه المشروعات يصل إلى أضعاف مضاعفة من الطلب الحقيقي على مثل هذا النوع من العقارات، وأسعارها لا تمت بصلة للقيمة الحقيقية التي تمثلها، أي قيمة الأرض والبنية التحتية والمنشآت.
إن الأزمة القادمة في هذا القطاع سيكون لها تأثيرًا مبالغاً يضاعف من تأثير العوامل السابقة على الإقتصاد المصري. مرة أخرى سيدفع الثمن العمال والموظفون في شركات الإنشاءات والصناعات المغذية لها( الحديد والأسمنت والخشب، الخ) وسيؤثر أيضاً بشكل سلبي على الشرائح العليا من الطبقة الوسطى التي استثمرت مدخراتها في عقارات ستنهار أسعارها بسرعة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى انكماش الطلب على الصناعات التي تعتمد على استهلاك هذه الشريحة من سيارات وأجهزة كهربائية وغيرها.
إذا وضعنا في الاعتبار كل هذه الضغوط على الاقتصاد المصري، وما يحدث من حولنا بفعل الأزمة العالمية لاقتصادات الدول النامية، او الأسواق الناشئة الأكبر والأقوى، مثل البرازيل والمجر والمكسيك والهند وتركيا، فلنا أن نتوقع ما يلي:
1 – انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري الحقيقي إلى ما يقرب من الصفر، إن لم يكن بالسالب.
2- انخفاض قيمة الجنيه المصري، بكل ما يعنيه ذلك من زيادة في الأسعار، وفقدان الثقة في الاقتصاد.
3- ارتفاع مطرد في نسبة البطالة والتشريد.
4- هجوم شرس من قبل الدولة والرأسماليين على أجور ومكتسبات العمال.
5- عودة الدولة إلى الاعتماد المباشر على مؤسسات التمويل الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي للاقتراض خشية الإفلاس.
7 الطرح الاشتراكي والمستقبل
هيمنت أفكار الليبرالية الجديدة، خلال العقود الثلاث الماضية على السياسات الاقتصادية لغالبية دول العالم سواء المتقدمة أو النامية، وكانت المحاور الأساسية لهذه المدرسة هي تخلي الدولة عن الدور المركزي في الاقتصاد من خلال الخصخصة و التحرير الاقتصادي وضرورة ترك المجال مفتوح أمام حركة رأس المال المالي والانتاجي حول العالم، وما يستلزمه ذلك من تخفيف الرقابة على تلك الحركة.
أخذت الليبرالية الجديدة دفعة كبرى مع انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية ومنظومة وسياسات رأسمالية الدولة فيها، فبدأ الحديث عن "نهاية التاريخ"، وأنه ليس هناك بديلاً للاقتصاد الرأسمالي الحر. وأخذت حكومات العالم الثالث تطبق السياسات الليبرالية الجديدة بشكل ديني خلال الثمانينات والتسعينات، وكانت النتيجة الأساسية لذلك هي تركيز غير مسبوق لرأس المال والثروة في أيدي قلة من رجال الأعمال المحليين في شراكة مع الشركات متعددة الجنسيات، في مقابل الإفقار الشديد للغالبية العظمى من العمال والفلاحين والموظفين والمهمشين.
والنتيجة الثانية كانت، مع ازدياد الاندماج مع السوق العالمية ومع ازدياد الاعتماد على الاستثمار والتمويل الاجنبي والتصدير. أن أصبحت تلك الاقتصادات معرضة لهزات عنيفة، كلما تقلب أو تأزم النظام الرأس مالي العالمي.
لقد ظهر ذلك جلياً في الأزمة المالية الكبرى التي أصابت اقتصادات جنوب شرق آسيا في ١٩٩٧-١٩٩٨، والتي سرعان ما امتدت إلى روسيا وأمريكا الجنوبية. وقد أحدثت تلك الأزمة أول الشروخ في مدرسة الليبرالية الجديدة، وفي هيمنتها العالمية، وبدأت أصوات تتعالى في قلب المؤسسات المالية العالمية تشكك في صحة تلك السياسات، فيما سمي بـ" ما بعد إجماع واشنطن". تلك الأصوات لم تكن اشتراكية بالطبع، فهي لم تشكك في النظام الرأسمالي نفسه، بل دعت إلى درجة أكبر من تدخل الدولة والرقابة على أسواق المال فحسب، أي إلى "ترشيد" الرأسمالية وجعلها أقل عرضة لتلك الهزات العنيفة.
جاء ثاني الشروخ في هيمنة الليبرالية الجديدة مع ظهور ما سمي بـ"حركة مناهضة العولمة الرأسمالية"، سلسلة المظاهرات الجماهرية الضخمة، بدءًا من سياتل في نهايات1999، والتي اجتاحت العديد من مدن العالم، حتى 2004، وقد تزامن ذلك مع ظهور حركات اجتماعية جذرية في أمريكا اللاتينية، معادية لسياسات الليبرالية الجديدة، والتي أوصلت عدد من الأنظمة اليسارية في تلك القارة المشتعلة، إلى الحكم.
ولكن، دون شك، جاء الشرخ الأكبر في منظومة الليبرالية الجديدة وهيمنتها مع الازمة العالمية الحالية ورد فعل كبرى الحكومات الرأسمالية تجاهها، فعمق واتساع الأزمة قد أظهر للجميع أن هناك خللا خطيرا في قلب النظام الرأسمالي، حت أن "آلان جرينسبان" الرئيس السابق للبنك المركزي الأمريكي وأحد مهندسي المنظومة الرأسمالية الأمريكية خلال العقدين الماضيين، قد اعترف مؤخرًا، أمام الكونجرس الأمريكي، أنه غير قادر على استيعاب ما أسماه بـ"التسونامي المالي العالمي".
كان رد فعل الحكومات للأزمة بتأميم البنوك الكبرى، والتدخل واسع النطاق في أسواق المال، أكبر اعتراف بفشل سياسات السوق الحر، وتحول بين يوم وليلة كبار المفكرين الاقتصاديين البرجوازييين من الدفاع الديني عن صنم حرية السوق، إلى دفاع لا يقل حماسا، عن السياسات الكينزية، (نسبة إلى "ماينارد كينز" الاقتصادي البريطاني الذي نادى خلال الثلاثينات بضرورة تدخل الدولة لخلق الطلب في الاقتصاد بعد الكساد العالمي الكبير(1929-1932).
لا تمت السياسات المتبعة اليوم لترشيد الرأسمالية، بالقطع، إلى الاشتراكية فالدولة اليوم تتدخل وتؤمم لإنقاذ الرأسمالية من نفسها وليس لتجاوزها. هذه السياسات والتي اسماها الاقتصادي الماركسي الكبير سمير أمين "بتأميم الخسائر وخصخصة الأرباح"، سوف يدفع ثمنها عمال وفقراء العالم، وليس أثريائها. ولكن على الرغم من ذلك، فهي تمثل فرصة تاريخية لصعود جديد لليسار الاشتراكي على مستوى الفكر والتحليل من جانب، وعلى مستوى الممارسة والنضال من جانب آخر، فهناك شرخًا عميقًا يصعب ترميمه في جدران الرأسمالية العالمية، وفي هيمنة منظومتها الفكرية والدعائية.
هناك فرصة تاريخية لطرح البديل الاشتراكي ذلك البديل الذي يريد نظاماً جديداً للإنتاج يكون هدفه تلبية حاجات البشر وليس الربح. نظاماً قائماً على التخطيط الديمقراطي لعملية الانتاج والتوزيع والاستهلاك وليس على فوضى السوق والتنافس والذي لا ينتج إلا الإهدار والأزمة والفقر للغالبية. نظاماً قائماً على المساواة بين البشر وليس تراكم المليارات (بالدولار) في أيدي قلة صغيرة من المحتكرين في حين يجوع مليارات (من البشر). نظاماً قائماً على الملكية العامة لوسائل الإنتاج تحت السيطرة الديمقراطية للعمال وليس على الملكية الخاصة والتي ظلوا يدافعون عن مزاياها في زيادة الانتاج والكفائة ولم نرى منها أبداً سوا الاحتكار والنهب والتداخل بين المال والسلطة. أما عن الكفائة فيكفينا أن ننظر للتريليونات التي تتبخر اليوم في ظل الأزمة المالية وإلى الماكينات التي ستتعطل والسلع المنتجة
يشهد الاقتصاد العالمي اليوم أكبر أزمة مالية منذ الكساد الكبير خلال الثلاثينات من القرن الماضي، ما هي الأسباب هذه الأزمة العنيفة؟ كيف بدأت؟ وكيف انتشرت من مركزها في قطاع التمويل العقاري الأمريكي لتشمل النظام الرأسمالي كله؟ هل ستتمكن الرأسمالية العالمية من الخروج من هذه الأزمة من خلال السياسات المطروحة الآن، من تدخل غير مسبوق للدولة وتقوية الأجهزة والإجراءات الرقابية على النظام المالي؟ كيف ستؤثر هذه الأزمة على الاقتصاد المصري، على معيشة ومستقبل الغالبية العظمى من سكان مصر، من العمال والفلاحين الفقراء؟ وماهي التحديات والفرص التي تطرحها هذه الأزمة وتوابعها، خلال الفترة القادمة أمام اليسار؟ وماذا علينا أن نفعل؟ ستحاول هذه الورقة طرح إجابات أولية علي هذه الأسئلة، التي يطرحها علينا هذا الواقع المأزوم.
(1)أسباب الأزمة:
يمكننا تقسيم النظام الرأس مالي إلى قسمين: القسم الأول هو رأس المال الإنتاجي-ويسمى أحيانا رأس المال الحقيقي-وهو رأس مال يتم استثماره في إنتاج السلع والخدمات، سواء الاستهلاكية، أو الإنتاجية، بهدف الربح، ومن خلال تشغيل واستغلال العمل المأجور، إذ يأتي الربح من خلال استخراج فائض القيمة، وهو الفارق بين ما يتم دفعه للعمال من أجور، وبين القيمة الحقيقية التي يخلقها هؤلاء العمال في العملية الإنتاجية، أما القسم الثاني من الرأسمالية فهو "رأس المال المالي"، وهو يتضمن البنوك التجارية والاستثمارية، والشركات التمويلية وسوق الأوراق المالية. المكون الرئيسي لهذا القسم هو البنوك التي تعتمد على إقراض الرأسماليين والأفراد والبنوك الأخرى، بمختلف تخصصاتها، مقابل الفائدة. وهناك علاقة عضوية بين رأس المال المالي ورأس المال الإنتاجي، فمالك المصنع مثلاً يحتاج إلى الاقتراض من البنك حتى يتمكن من شراء أدوات الإنتاج وقوة العمل، حتى تتم العملية الإنتاجية، ثم يتم بيع السلع المنتجة في السوق، وتحقيق الربح، والبنك لن يتمكن من تحقيق الفائدة، وهي السبب الوحيد لتقديم الائتمان، إلا إذا استثمر ذلك الائتمان بشكل منتج، وحقق الأرباح التي سيدفع منها المستثمر، قيمة ما اقترضه،بالإضافة إلى الفائدة.
ولكن مع توسع وتطور النظام الرأسمالي، تصبح العلاقة بين رأس المال المالي ورأس المال الإنتاجي أكثر تعقيدًا، فالبنوك على سبيل المثال، لا تستثمر أموالها فقط في إقراض الرأسمالي المنتج، بل تضخ الأموال في إقراض الأفراد(الرهن العقاري، وكروت الائتمان، مثلا)، وفي شراء الأسهم والسندات، في أسواق الأوراق المالية(البورصات).
وتصبح الشركات الرأسمالية الصناعية الكبرى، مع ازدياد حجمها، وتوسع إنتاجها وأسواقها على مستوى العالم، لاعبا أساسيًا في قطاع رأس المال المالي، فتخلق لنفسها أذرعا تمويلية، ويتم تداول أسهم شركاتها كأوراق مالية في البورصات، وتستثمر جزءًا متزايدا من فوائضها في أسواق المال.
ولكن يظل أساس النظام هو الإنتاج الرأسمالي للسلع، فمن هنا تأتي الأرباح، التي يتم تداولها في أسواق المال، ومن هنا تأتي الأجور، الدخول الحقيقية التي يتم بها شراء السلع والخدمات التي تنتجها الرأسمالية، فالمال لا يخلق نفسه، ورأس المال المالي، في حد ذاته، لا ينتج أي شيء على الإطلاق، فالبورصة على سبيل المثال هي سوق لأوراق مالية، تمثل في بدايتها قيمة الشركات التي تعبر عنها، ولكن مع بيع وشراء هذه الأسهم والمضاربة عليها، تبتعد قيمة الاسهم(الأوراق) عن القيمة الحقيقية للشركات أو السلع الحقيقية التي تمثلها، هبوطًا وصعودًا، طبقا للعرض والطلب عليها، وليس بالضرورة طبقًا لأصولها في العالم الحقيقي، وهذا "العالم الافتراضي"، والذي يسميه ماركس "رأس المال الافتراضي"، بأوراقه وأرقامه وإشاراته الإليكترونية على شاشات الكومبيوتر، يخلق ويدمر ثروات طائلة، في ثوان معدودة.
وكلما كانت معدلات الربح في القطاع الإنتاجي ضعيفة، تهرب الاستثمارات من مجال التوسع الإنتاجي، من مصانع وبنية تحتية..إلخ، وتتراكم في هذا القطاع المالي الافتراضي، وكلما تضخم هذا القطاع وكلما ابتعدت القيمة الافتراضية الورقية عن القيمة الحقيقية، أي عن قيمة الشركات بأدوات إنتاجها ومنشآتها، وأرباحها الإنتاجية، كلما أصبح النظام عرضة لأزمة مالية أكثر عنفا.
تعد الأزمة المالية الحالية، التي يعاني منها الاقتصاد الرأسمالي، تتويجاً لسلسلة من الأزمات التي عصفت بالرأسمالية العالمية، منذ مطلع السبعينيات من القرن العشرين، وهي بلا شك أخطر هذه الأزمات منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن نفسه.
ولكن جذور هذه الأزمات المالية لا تقع في القطاع المالي بل في قلب نمط الإنتاج الرأسمالى نفسه. فالإنتاج في الرأسمالية لا يتم من أجل تلبية حاجات البشر ولكن من أجل الربح. وهذه العملية تتم بشكل تنافسي بين الشركات الرأسمالية. كل شركة تحاول تعظيم أرباحها ونسبة مبيعاتها في الأسواق من خلال تكثيف استغلال عمالها ومن خلال توسيع وتطوير إنتاجها بالاستثمار في أدوات الإنتاج (بتطوير أو تغير الميكنة علي سبيل المثال)..وهذه الطبيعة التنافسية والاستغلالية للإنتاج الرأسمالي تؤدى إلي عدد من التناقضات الجوهرية. فأولاً كلما ازداد حجم الاستثمار في أدوات الإنتاج كلما تناقص الحجم النسبي لمصدر الربح الحقيقي وهو قوة العمل التي يتم استغلالها وهو ما يؤدي على المدى الطويل إلى ميل معدلات الربح للانخفاض. وثانياً تحتاج الشركات حتي تحصل علي أرباحها إلى أن تباع منتجاتها في السوق وإذا انخفضت القدرة الشرائية للعمال بفعل تكثيف استغلالهم فلن يتمكنوا من شراء تلك السلع وتكون النتيجة تراكم فائضاً للانتاج وهو ما يؤدي بدوره إلي تقليص الأرباح وتقليص شراء الرأسماليين للسلع الإنتاجية (المواد الخام والميكنة وغيرها من أدوات ومستلزمات الإنتاج). هذه التناقضات والتي لن ندخل في تفاصيلها في هذه الورقة القصيرة تؤدي ليس فقط إلي أزمات متتالية بل إلي البحث الدائم من قبل الرأسمالية عن مجالات للاستثمار تعوضها عن ضعف الأرباح في المجال الإنتاجي وهو ما شكل أحد الدوافع الرئيسية لتضخم القطاع المالي خلال العقود الثلاث الماضية.
(2)كيف تطورت الأزمة الحالية؟
يلعب سعر الفائدة، الذي يحدده البنك المركزي، دورًا رئيسيًا في تحديد سهولة ووفرة الائتمان في السوق الرأسمالي بشكل عام، فعندما يرفع البنك المركزي سعر الفائدة، يكون ذلك سببًا في عدم الاقتراض من البنوك، والإبقاء على الأموال فيها، والاستفادة من الفائدة العالية، وعندما يتم تخفيض سعر الفائدة يكون ذلك حافزًا للاقتراض والاستثمار في مشروعات مربحة. ولكن، إذا انخفضت أسعار الفائدة، ولم يكن هناك مجالاً إنتاجيًا مربحًا، فيتم توظيف القروض في مجالات غير إنتاجية، مثل سوق الأوراق المالية، وشراء العقارات، وغيرها. وهذا بالضبط ما حدث مع الاقتصاد الأمريكي، في مطلع القرن الواحد والعشرين، فقد واجه البنك المركزي الأمريكي الكساد النسبي، الذي عانى منه الاقتصاد الأمريكي في ذلك الحين، والذي ازداد عمقاً منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001، عن طريق تخفيض سريع لسعر الفائدة، من أجل تشجيع الاستثمار المنكمش.
أصبح الاقتراض السهل هو عنوان المرحلة، وتسابقت البنوك والصناديق التمويلية للاستفادة من تلك الأموال"السهلة"، وكان أحد المجالات الرئيسية لاستثمار تلك الأموال هو قروض الرهن العقاري للأفراد، وكانت هناك تسهيلات غير مسبوقة، في شروط وضمانات هذه القروض، وهي نتيجة منطقية، ليس فقط لما يتصوره البعض لفقدان الراقابة والضوابط، ولكن أيضًا، وهو الأهم، نتيجة للسيولة المالية التي أحدثها تخفيض سعر الفائدة، مع تضاؤل ربحية المشروعات الإنتاجية.
ملايين العائلات الأمريكية شرعت في شراء العقارات، من خلال قروض الرهن العقاري، مما زاد بشكل جنوني من أسعار العقارات في السوق الأمريكي(بنسبة تصل من200% خلال الفترة2001: 2006) وهو ما أدى بدوره إلى زيادة جاذبية هذا القطاع للاستثمارات المالية من قبل البنوك. كان مركز قروض الرهن العقاري، هو البنوك المتخصصة في هذا المجال، مثل العملاقين الامريكيين "فريدي ماك" و"فاني ماي"، أكبر شركتين في هذا المجال على مستوى العالم.
ولكن، وبسبب سياسات التحرير الاقتصادي، خاصة في المجال المالي، وعولمة المنظومة المالية الرأسمالية، تطورت أسواقًا لتداول أوراق الرهن العقاري، شملت البنوك والشركات المالية، ليس في السوق الأمريكية وحدها بل على مستوى العالم، واكتظت خزائن هذه البنوك والشركات بتلك الأوراق الممثلة للرهون العقارية، فيما يُطلق عليه الاقتصاديون ظاهرة "التوريق"، وهو ما أدى إلى خلق فقاعة "افتراضية" لقيم العقارات الأمريكية(وكذلك في اسبانيا وأيرلندا، وغيرها...)، فالقيمة الورقية للعقارات أبتعدت تماما عن القيمة الحقيقية لتلك العقارات، وقيمة الأوراق الممثلة للرهون العقارية، أخذت أيضًا تتباعد عن القدرة الحقيقية للمقترضين الأصليين على تسديد الأقساط وفوائدها. سرعان ما اصطدم "الافتراض" بـ"الواقع"، فتوقف عدد من المقترضن عن سداد الأقساط، ومن ثم بدأت البنوك العقارية في الحجز على العقارات، وطرد سكانها، مما تسبب في حالة من الذعر في القطاع المالي بأكمله، فلم يعد أحد يعرف بالضبط، ما هي نسبة القروض"السيئة"، التي لن يتم سداد قيمتها، ولا درجة انتشار تلك الأوراق، التي تم تداولها في القطاع المصرفي بوجه عام.
كانت بداية الانهيار في إفلاس بنك"بير ستيرنز" العريق، والذي اتضح أنه كان غارقا في تلك الأوراق "السيئة" في صيف ٢٠٠٧. ومع انشار حالة الذعر بدأت أسعار العقارات في انخفاض سريع. وأصبح الكثير من المقترضين مدينين للبنوك بأكثر من قيمة العقارات التي يدفعون أقساطها، مما زاد من تعقيد الأزمة.
بلغت الأزمة ذروتها في مطلع شهر سبتمبر2008، حينما أوشك العملاقين"فريدي ماك" و"فاني ماي"، على الانهيار، وتدخلت الحكومة الأمريكية لتأميم الشركتين على الفور، رغم ثلاثون عاما من الدعاية الإيديولوجية عن حرية السوق"، وضرورة عدم تدخل الدولة في الاقتصاد.
وفي منتصف سبتمبر افلس بنك "ليمان برازرز" العريق، الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر، لكن الحكومة لم تتدخل لإنقاذ البنك، معبرة عن حالة من التذبذب وعدم ضوح الرؤية، والتي سرعان ما انعكست في مزيد من الذعر في الأسواق، وشهدت بورصة نيويورك، وغيرها من البورصات العالمية موجات متتابعة من الانهيار. وتلى ذلك على الفور قيام الحكومة الأمريكية بضخ85مليار دولار لشراء أسهم أكبر شركة تأمين في العالم(آي.آي.جي)والتي كانت هي الأخرى على وشك إشهار إفلاسها. لكن، حتى هذا الإجراء، غير المسبوق، منذ ثلاثينيات القرن الماضي، لم ينجح في تهدئة حالة الذعر في الاسواق، وظلت البورصات العالمية تشهد انهيارات غير مسبوقة، فانتقلت الازمة سريعا من النظام المالي الأمريكي إلى النظام المالي العالمي.
انتشرت الازمة مثل النار في الهشيم، لتشمل البنوك والشركات التمويلية والبورصات في أوروبا وآسيا، وكافة المراكز الرأسمالية الكبرى. فمن جانب ، وبسبب سياسات العولمة وتحرير الأسواق، انتقلت الكثير من تلك الأوراق "المسمومة" من البنوك الأمريكية إلى البنوك الأوروبية والآسيوية، وآخذت البنوك، الواحد تلو الآخر، في إشهار إفلاسها، وقامت الحكومات بدورها، الواحدة تلو الأخرى، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بتأميم البنوك أو شراء الأسهم، وضخ المليارات في سوق المال، ولكن ظل الذعر مسيطرًا على الأسواق، وأصاب الشلل النظام البنكي سواء في أمريكا، أو في المراكز المالية الأخرى، ولعل أهم مؤشر على ذلك هو امتناع البنوك الاستثمارية عن إقراض بعضها البعض، فلا أحد يعرف من سيُفلس قبل الآخر، وما مدى امتلاء خزانة كل منهم بتلك الأوراق "المسمومة".
كان هناك عاملاً آخر لتفاقم آثار الأزمة، ألا وهو الخلل الكبير منذ نهاية التسعينات بين المدخرات في الأسواق الناشئة مثل الصين ودول الخليج، وبين العجز المتزايد في ميزان مدفوعات الاقتصاد الأمريكي، فدول مثل الصين شهدت طفرة كبيرة في التصنيع التصديري، وكانت الولايات المتحدة هي المستورد الأكبر لتلك الصادرات، في المقابل، كان الفائض الصيني يتم إدخاره بالدولار، كما كان يتم استثمار جزء كبير منه في البنوك وسندات الخزانة الامريكية، وهو ما أدّى بدوره إلى توسُّع غير مسبوق في دائرة الإقراض للمستهلكين الأمريكيين.
وهكذا، أصبح المستهلك الأمريكي قادرا على شراء الصادرات الصناعية الصينية، ليس من خلال الدخل الحقيقي لهؤلاء المستهلكين، ولكن بالاقتراض من البنوك، عن طريق كروت الائتمان. وكما في حالة العقارات، أصبح المستهلك الأمريكي يعيش بالدَيْن، وأصبح مستوى معيشته، والسلع التي يستهلكها، ليس انعكاسا للزيادة في دخله، ولكن لسهولة الاقتراض من البنوك. فالصين تصدر سلع لأمريكا، والمستهلك الأمريكي يقترض لشراءها، ثم يُضَخ الفائض الذي تراكمه الصين في البنوك وسوق المال الأمريكيين، مما يؤدي إلى المزيد من الإقراض للمستهلك الأمريكي، وبالتالي شراء المزيد من السلع الصينية. وهكذا، نشأت تلك الدائرة الجهنمية وتوسعت، وهذا الخلل أنتج بدوره المزيد من الهشاشة في النظام المالي العالمي. مع أزمة البنوك الأمريكية والأوروبية، وعدم قدرتها على الإقراض، تتضائل قدرة المستهلك الأمريكي والأوروبي على الشراء، وبالتالي يؤثر ذلك سلبًا على اقتصاد البلدان المُصدّره، مثل الصين.
(3)تأثيرات الأزمة:
أ-الدول الصناعية الكبرى:
لقد طرحنا فيما سبق أن الأزمة الحالية قد بدأت وانتشرت في القطاع المالي، وسرعان ما انتقلت، كما هو متوقع، إلى بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الإنتاجي، فالانكماش في قدرة البنوك على الإقراض، يعني انكماشا في مصادر تمويل الشركات الصناعية والإنتاجية، فهي تحتاج بشكل دائم إلى سيولة ائتمانية، لتغطية مصروفاتها، وللإنفاق على تطوير وتوسيع إنتاجها، ويؤدي ذلك الانكماش بالضروروة، إلى تقليص الأنشطة، في حالة الشركات الكبرى-إغلاق مصانع أو وقف مشروعات التوسع- وإلى إفلاس الشركات الأصغر، غير القادرة على مواجهة العاصفة المالية، وهو ما يؤدي بدوره، إلى زيادة مطّردة في حجم البطالة، حيث تتخلص الشركات من العمالة لتقليص الإنفاق.
وتؤدي الزيادة في البطالة، بالطبع، إلى انخفاض حاد في القدرة الشرائية، وبالتالي، في استهلاك السلع التي تنتجها الشركات. والشركات، بالطبع، لا يمكنها أن تستمر في الإنتاج، إن لم تضمن وجود من يشتري منتجاتها، وقد أعلنت كبرى الشركات الصناعية، في مجالات صناعة السيارات والإلكترونيات والحديد والأسمنت عن خسائر كبرى في الربع الثالث من عام 2008، مع توقعات بمزيد من الخسائر في الفترة القادمة، وهذا بدوره لن يؤدي إلا إلى المزيد من البطالة، وانخفاض في القدرة الشرائية للمستهلكين.
وكما هي العادة في كل الأزمات الرأسمالية، فالعمال والفقراء هم من يتحملون العبء الأكبر من تبعات الأزمة، فالعامل الأمريكي أو الأوروبي يفقد بيته لأنه غير قادر على دفع أقساط الرهن العقاري، ويفقد القدرة على الاقتراض من البنوك التجارية، وفي النهاية يفقد وظيفته لينضم إلى جيش العاطلين.
ب-الدول النامية
تبنت حكومات غالبية الدول النامية خلال العقدين الماضيين السياسات الاقتصادية المعروفة بإسم "الليبرالية الجديدة"، بهدف ربط اقتصاداتها بالمراكز الرأسمالية الكبرى، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والإنتاج التصديري وتحرير السوق من خلال الخصخصة وتحرير أسواق السلع والعقارات والخدمات وتقليص دور الدولة في الاقتصاد بشكل عام. كانت نتيجة تلك السياسات الكارثية، كما نعرف، عملية نهب منظم لحقوق ومكتسبات الأغلبية من السكان، من العمال والفلاحين الفقراء، لصالح كبار المستثمرين المحليين والشركات متعددة الجنسيات.
كانت إحدى النتائج الأخرى الرئيسية لتلك السياسات هي إدماج اقتصاد غالبية الدول النامية في المنظومة المالية والاقتصادية العالمية، وبالتالي تعريضها بشكل دائم لتقلبات وأزمات، وفوضى تلك المنظومة. وكما رأينا في أزمة1997-1998، التي بدأت في جنوب شرق آسيا ، وامتدت إلى روسيا والبرازيل، وغيرها من "الأسواق الناشئة"، فالاستثمارات الأجنبية تنسحب بسرعة البرق من تلك الأسواق عند أول إشارة للأزمة، وسرعان ما تتعرض عملات وبورصات تلك الدول للانهيار بفعل مزيج من الذعر والمضاربة من قبل كبار المستثمرين، واعتماد تلك الدول على التصدير يفترض استقرار الاستهلاك والنمو في الدول الرأس مالية الكبرى، ويفترض أيضا القدرة على توجيه الاستثمارات الصناعية نحو إنتاج السلع التي يزداد عليها الطلب في السوق العالمية، في ظل منافسة شرسة بين الدول النامية، التي ينتج الكثير منها السلع نفسها. هذه الافتراضات سرعان ما ينكشف قصورها في ظل الفوضى السوق الرأسمالي العالمي، وهكذا رأينا في1997-1998 موجة من الانهيارات في جنوب شرق آسيا كان أعنفها في إندونيسيا، التي وصلت نسبة البطالة فيها إلى40%، وانهارت عملتها وبورصتها، وآثار الأزمة رغم ضراوتها، ورغم الجوع والفقر والتشريد التي تسببت فيها، تعتبر محدودة للغاية، إذا قارناها بما نواجهه اليوم، فقد تركزت تلك الأزمة في مناطق بعينها، وكان تأثيرها محدودًا في كبرى مراكز التركز الرأس مالي العالمي. لكن الأزمة هذه المرة قد أصابت قلب النظام الرأس مالي نفسه، ولن ينجو أحد من تبعاتها.
لقد بدأت آثار الأزمة العالمية بالفعل على اقتصاد الدول النامية، حتى أقواها، وهي الصين، فرأس المال الأجنبي، أي الشركات متعددة الجنسيات، قامت بعملية هروب كبير من الأسواق الناشئة، وازدادت مؤشرات انهيار البورصات، فحتى بورصة شنغهاي الصينية فقدت أكثر من 50% من قيمتها في الشهور الثماني الأولى من عام2008، وتم سحب ما يقرب من80مليار دولار من الأسواق الناشئة بين يونيو وسبتمبر الماضيين، وقد قدرت مؤسسة "مورجان ستانلي" المالية أن التدفقات المالية إلى الدول النامية ستنخفض خلال 2009، بما يتجاوز200مليار دولار بما سيزيد من العجز في ميزان المدفوعات لأكثر من 80دولة في العالم الثالث.
إلى جانب الهروب الكبير للاستثمارات الأجنبية، هناك الانكماش الأكبر لصادرات دول العالم الثالث، والتي تعتمد معظمها على أسواق الدول الرأسمالية الكبرى، وقد رأينا ما يحدث للمستهلك الأمريكي على سبيل المثال، بكل ما سينتج عنه من إفلاس وإغلاق للمصانع، وزيادة سريعة في نسبة البطالة والفقر والتشريد.
لقد عانى فقراء العالم الثالث، طوال العامين الماضيين، من تضخم غير مسبوق في أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام، وأحد الآثار المباشرة للركود العالمي الحالي هو انخفاض حاد في أسعار تلك السلع، بسبب الانخفاض السريع للطلب العالمي، لكن فقراء العالم الثالث لن يستفيدوا كثيرًا من تلك الانخفاضات في الأسعار، لماذا؟ أولا لأن انخفاض أسعار السلع الأساسية لا ينعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية، فالمستفيد الأول منها سيكون كبار محتكري تلك السلع في بلدان العالم الثالث، وثانيا لأن البطالة وانخفاض الأجور الحقيقية سيكون أسرع وأكبر، بفعل الأزمة، من الانخفاض في الأسعار، فالعامل العاطل والفلاح المعدم لن يستفيد من انخفاض محدود في أسعار السلع. وثالثا لأن أحد التأثيرات الهامة للأزمة الحالية سيكون انهيار قيمة عملات كثير من الدول، فقد انخفضت قيمة عملات البرازيل والمجر وأوكرانيا وإندونيسا بنسب تتراوح بين20%:50%، والبقية تأتي. يعني ذلك تضخما في أسعار السلع الأساسية التي تستوردها بلدان العالم الثالث. رابعًا، لأن الكثير من تلك الدول تعتمد على تصدير السلع الغذائية والمواد الخام، وبالتالي فإن انهيار اسعارها سيؤدي إلى انهيار قيمة صادراتها، وما له من تأثير مدمر على فقراء الفلاحين.
(4)الحلول المطروحة للأزمة:
هيمنت خلال العقود الثلاث الماضية أفكار وسياسات حرية السوق الليبرالية الجديدة على الغالبية العظمى من حكومات العالم، وجوهر هذه الرؤية هو ضرورة تقليص دور الدولة في الاقتصاد، من خلال الخصخصة و"تحرير الأسواق" في كافة القطاعات المالية والصناعية والخدمية، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية والتأمينات. وقد رأينا خلال الأزمة الحالية كيف اضطرت حكومات الدول المتقدمة، وعلى رأسها الحكومة الأمريكية أن تتبنى سياسات تتناقض كليًا مع ما ظلت تطرحه في دعاياتها، وفي السياسيات التي تفرضها عن طريق البنك وصندوق النقد الدوليين على مختلف بلدان العالم.
نحن نشهد، خلال هذه الأزمة، أكبر تدخل حكومي في الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية، فالبنوك المركزية تنفق الترليونات في تأميم كبرى البنوك العالمية وشركات التأمين، وفي شراء الأسهم والأوراق المالية "المسمومة" وهذا كله في محاولة محمومة لإنقاذ النظام من حالة الشلل المالي التام، ومن الانزلاق في كساد كبير، يتجاوز حجمه وتأثيره كساد الثلاثينات من القرن العشرين.
تطرح هذه السياسات الجديدة تحولاً، حتى وإن كان مؤقتا في فلسفة "السوق الحر" الليبرالية الجديدة ،إلى واقع رأس مالية الدولة والتأميم، وهو تحول يخلق شرخً ضخما في الهيمنة الفكرية البرجوازية بمؤسساتها الإعلامية، وجامعاتها، وصانعي سياساتها الاقتصادية. وإذا نحينا جانبا تلك الأزمة الفكرية التي تخلقها هذا التحول الحاد في السياسات، فإنه يبقى السؤال المُلِح، والمباشر: هل ستتمكن الحكومات من إنقاذ النظام من خلال هذه السياسات؟.
أول ما يجب طرحه في الرد على هذا السؤال هو أن علينا أن نتوخى الحذر الشديد بشأن التنبؤات حل مصير الاقتصاد العالمي، فالمتغيرات والعوامل متعددة ومعقدة، ولا يمكن التكهن بدقة حول احتمالات تفاعل وتطور هذه المتغيرات والعوامل.
على المدى القريب، يبدو حتى وقت كتابة هذه السطور(نهاية أكتوبر2008) أن التدخل الحكومي غير المسبوق في سوق المال والبنوك، وعلى رأسها الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، قد مكنهم من تفادي الانزلاق في كساد عالمي كبير وفي شلل كامل لسوق المال العالمي. لكن هذه السياسات التدخلية لم ولن تنقذ الرأسمالية من الدخول في ركود عالمي عميق خلال العامين القادمين.
كانت تقديرات صندوق النقد الدولي تشير، في منتصف سبتمبر، إلى أن اقتصاد الدول الرأسمالية الكبرى لن يتجاوز0.5%خلال عام2009، وهو ما يعني عمليًا انكماشًا حادًا في تلك الاقتصادات، وتشير التقديرات نفسها إلى أن الاقتصاد العالمي ككل لن يتجاوز نموه 3% خلال العام القادم، فقد تراجع نمو الاقتصاد الصيني من أكثر من12%إلى أقل من 9%خلال2008، وبالطبع يكون أثر الركود العالمي أكبر وأخطر على اقتصاد الدول الأضعف، فدول مثل باكستان وتركيا والمجر والبرازيل والأرجنتين، وإندونيسيا على رأس الاقتصادات المهددة بالانهيار، وهذه هي مجرد بداية.
ولكن وعلى المدى الأطول فهناك عدد من العوامل التي يمكنها أن تجعل من الركود العالمي الحالي مجرد مقدمة لأزمات أكثر حدة في النظام الرأسمالي العالمي. أول هذه العوامل أن البنوك المركزية التي تضخ آلاف التريليونات اليوم، يجب ان تأتي بهذه التريليونات من مكان ما، والمصدر الرئيسي للمال الحكومي هو الضرائب، وهو ما يعني أن الأموال التي يتم ضخها اليوم هي حصيلة الضرائب في المستقبل، وبالطبع من سيدفع الثمن هم الغالبية العظمى من دافعي الضرائب وهم العمال والموظفون. ولكنه أيضًا يمثل رهانًا غير مضمون، إذ يقوم على افتراض أن الاقتصاد سيتعافى للدرجة التي تمكن الدولة من تحصيل الضرائب اللازمة لدفع الفاتورة المهولة للأزمة!. وبالطبع يمكن للدول أن تطبع الأموال، لكن ذلك يعني الدخول في حالة تضخم خطيرة.
العامل الثاني هو أن الحجم النسبي للبنوك المركزية وما تستطيع توفيره من اموال قد تضائل بسبب النمو غير المسبوق للشركات الاحتكارية العملاقة ، متعددة الجنسيات، وهو ما يعني أن قدرة البنوك المركزية في إنقاذ مثل هذه الشركات العملاقة يصبح موضع شك.
العامل الثالث هو أن التداخل والاندماج في الاقتصاد الرأس مالي العالمي يصعبان بشدة من مهمة البنوك المركزية، فالأمر يحتاج إلى درجة من التنسيق والوحدة بين البنوك المركزية، يصعب تحقيقها في عالم قائم على التنافس، ليس فقط بين الشركات، ولكن أيضًا بين الدول الرأسمالية المختلفة. ويجدر هنا الإشارة إلى ما حدث في اليابان في تسعينات القرن العشرين، حين دخل الاقتصاد الياباني في حالة ركود طويلة، فقام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، من أجل تنشيط الاقتصاد في حين كان سعر الفائدة في أوروبا وكثير من الأسوق الناشئة يتجاوز 4%. كانت إحدى نتائج ذلك هي قيام المستثمرين بالاقتراض من بنوك اليابان، وإيداع الأموال في بنوك الدول ذات سعر الفائدة الأعلى، وبالتالي من تحقيق ربح صافي من الفارق بين أسعار الفائدة، بمجرد تحويل الأموال من بلد إلى أخرى.
من كل ما سبق، يمكننا القول أنه ربما يكون الاقتصاد العالمي قد تفادى كسادًا كبيرًا، ولكن، رغم كل الأموال التي تُضَخ فإنه لم يتمكن من تفادي ركود عالمي عميق، وأنه على المدى البعيد، لن يتمكن من الإفلات من أزمات أعنف ومن زلازل أكثر تدميرًا.
5 الحل الرقابي والحل الإسلامي
تمتليء الساحة بالكثير من التفسيرات للازمة الحالية ولوسيلة الخروج منها، لعل أكثرها سذاجة هي تلك القائلة بأن المشكلات تكمن في غياب الرقابة الكافية على القطاع المالي فحسب. أي أن الأجهزة الرقابية لم تلعب دورًا كافيًا في الحد من المضاربة في الأوراق المالية ومراقبة شروط وضمانات القروض التي تقدمها البنوك، وعلى المستوى السطحي لا خلاف حول تخفيف دور الأجهزة الرقابية خلال العقد الماضي، لكن مشكلة ذلك التفسير هو أنه يخلط بين النتيجة والسبب، فكما حاولنا أن نبين في الجزء الأول من هذه الورقة، أن سياسة البنك المركزي الأمريكي خلال العقد الماضي، وخاصة بعد أزمة 2001، كانت في جوهرها محاولة خلق سيولة مالية، من خلال تخفيض سعر الفائدة، وضخ الأموال وتوسيع دائرة الاقتراض، بحيث تنقذ الاستهلاك الأمريكي من الانكماش، وهو ما نتج عنه تجاوز البنوك والشركات المالية لقواعد الرقابية، وليس العكس.
وهناك تفسيراً آخراً لا يقل سذاجة وهو ما سمي بالتفسير الإسلامي. وقد أعد د.عبد الحميد الغزالي، القيادي الإخواني، بناءًا على تكليف من المرشد العام، ورقة يقدم فيها تفسيرًا للأزمة وسبل الخروج منها، وفقا لروية إسلامية. لا يخرج الجزء الأكبر من الورقة عن التفسير السطحي الذي يطرحه الاقتصاديون البرجوازيون في الصحف والفضائيات، الا وهو أن الأزمة ليست في التناقضات الجوهرية في النظام الرأسمالي، فالمشكلة كما يصورها د..الغزالي هي غياب أو تغييب الرقابة على منظومة الإقراض، وفي أسواق الأوراق المالية، وجشع المنتفعين بها. لكن ما يميز الورقة هو الحل الذي تطرحه للأزمة، فهو يدعو إلى "التفكير الجاد في دراسة تطبيق النظام الإسلامي البعيد عن سعر الفائدة "الربوي"، والقائم على معدل الربح كآداة فعالة لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر، والذي يستند إلى القيام باستثمار حقيقي لتوسيع القاعدة الإنتاجية، وليس على أساس استثمار مالي قوامه المضاربات، أو المقامرة أو الاستغلال أو الفساد...."
فالمشكلة، وفقا "للمنظور الإسلامي" المطروح ليست في الربح الرأسمالي، الذي يأتي من استغلال العمال ونهب فائض قيمة عملهم، بل في الإقراض بالفائدة أو "الربا"، أي أن الأرباح الرأسمالية التي تأتي مما يسميه الاستثمار الحقيقي "حلال"، أما الإقراض بالفائدة فهو "حرام". ونحن لا نرمي إلى الخوض في المسائل الفقهية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، ولكننا نشير إلى التناقض الصارخ في "الطرح الإسلامي" بين الرغبة في الإبقاء على منظومة الربح الرأسمالي، القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، واستغلال العمال، وفوضى السوق وبين الرغبة في القضاء على أحد الأعمدة الرئيسية لهذه المنظومة، وهو النظام البنكي القائم على الفائدة. لقد طرحنا في بداية هذه الورقة كيف أن البنوك(رأس المال الحامل للفائدة)، والرأسمالية الإنتاجية(رأس المال الحامل للربح) هما في الواقع وجهان لعملة واحدة. فالأول لا يمكنه البقاء إلا على أساس وجود أرباح "حقيقية" من إنتاج "حقيقي"، والثاني لا يمكنه البقاء إلا على أساسا وجود نظام مالي مستقل نسبيًا، يمنحه السيولة والمرونة المالية التي يحتاجها لتغطية نفقاته، خاصة في الفترة الزمنية بين البدء في عملية الإنتاج، وبين لحظة تحقيق الربح في السوق، أما الفائدة فهي الثمن الذي تفرضه البنوك مقابل تقديم تلك الخدمة.
فنحن، إذًا، لا يمكننا في الواقع، وبالاستدلال المنطقي، أن نفصل بين الربح الرأسمالي وبين الفائدة، أو "الربا" التي يصفها الغزالي ، في نهاية ورقته، بقولة "كبيرة الربا وراء كل الشرور الاقتصادية التي تعاني منها البشرية"، وهو بالتالي يبريء عملية الاستغلال الرأسمالي من هذه "الشرور"، ويرى أنها "حلال".
كان "الربا" قديمًا، ولا تزال "الفائدة" في العصر الرأسمالي الحديث، كارثة فعلية تعاني منها البشرية، ولكنها جزء لا يتجزأ من النظام الرأسمالي القائم على الربح، ومن يريد حقًا أن يقضي على آفة "الربا" عليه أن يقضي على منبعها، وسبب وجودها الحقيقي، وهو النظام الرأسمالي نفسه، وإلا فإن أطروحته تصبح، ليست ساذجة وغير منطقية فحسب، بل أيضا داعمة ومبررة للرأسمالية بكل شرورها.
(6)مصر والازمة العالمية:
من يتابع تصريحات وزراء حكومة نظيف حول الازمة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، لا يمكنه إلا أن يشعر ببعض الشفقة وكثير من الغثيان. فهناك، أولا تخبط وتضارب في التصريحات من يوم لآخر ومن وزير لآخر، فمع بداية الازمة أعلن محمود محي الدين، وزير الاستثمار، أن مصر لن تتأثر بالأزمة كثيرًا، بل يمكنهاالاستفادة منها!. ومع التناقض الشديد بين هذلية هذه التصريحات وبين واقع انهيار البورصة، وانخفاض قيمة الجنية، بدأ الحديث عن احتمال انخفاض معدل النمو المزعوم من7: 6%، وتنوعت تقديرات الانخفاض بين وزير وآخر في الحكومة نفسها. وهم معذورون في هذه الحالة من التخبط والهذيان، فهم ملكيون أكثر من الملك، وعندما يرون الصنم الذي يعبدونه-اقتصاد السوق الحر والعولمة-ينهار أمام أعينهم، وعندما يرون نفس الحكومات والمؤسسات العالمية الكبرى يقومون بتأميم أكبر البنوك الخاصة، في وقت يتباهى فيه وزرائنا ببيع بنوك القطاع العام، لنفس تلك البنوك العالمية المنهارة. عندما يرون كل ذلك، وهم مجرد ببغاوات يرددون ما ظلوا يسمعونه في واشنطن طوال العقود الثلاث الماضية، فمن الطبيعي أن يتخبطوا في تصريحاتهم وفي سياساتهم.
لكن!، ما هو التأثير الحقيقي للأزمة الحالية على الاقتصاد المصري، بعيدًا عن مهاترات المسئولين والاقتصاديين في حكومة رجال الاعمال المصرية؟، وعلاما يعتمد هذا الاقتصاد اليوم؟ يمكننا تحديد عدد من المحاور الاساسية وهي الاستثمار الاجنبي والسياحة، وقناة السويس، والتصدير، والطفرة في سوق العقارات.
بالنسبة للاستثمار الأجنبين فقد رأينا كيف يحدث اليوم هروبًا كبيرًا لاستثمارات الشركات العالمية من أسواق الدول النامية، بما فيها أقوى تلك الأسواق(البرازيل والمكسيك والمجر والهند...) وقد رأينا أول تأثيرات ذلك في البورصة المصرية، والتي فقدت أكثر من50%من قيمة أسهمها خلال الشهور الستة الماضية. الأمر نفسه ينطبق على الاستثمارات العقارية والإنتاجية، التي وصلت خلال العام 2007/2008 إلى 11مليار دولار، فأول ما يهتز عندما يتعرض النظام الرأسمالي لأزمة عنيفة هو ثقة المستثمرين في "الأسواق الناشئة" فيقومون بسحب ما يستطيعون من رؤوس أموالهم من تلك الأسواق، وإلغاء كافة خطط التوسع في تلك الأسواق، وتقليص تواجدهم فيها إلى حدّه الأدنى. فمن المتوقع إذا أن تنكمش الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال العامين القادمين.
أما السياحة فيمثل دخلها أكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي المصري، وحوالي 20% من مصادر النقد الأجنبي. وقد وصل عدد السياح في 2007/2008إلى حوالي 10ملايين سائح، ويشتغل بقطاع السياحة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، اكثر من مليون عامل وموظف. وتأتي الغالبية العظمى من السياحة في مصر من أوروبا وامريكا وروسيا واليابان ودول الخليج. وقد رأينا كيف ينكمش استهلاك المواطنين في الدول الرأسمالية الكبرى سريعا، ورأينا كيف يفقدون بيوتهم ومدخراتهم ووظائفهم، ومن لم تطاله العاصفة بعد، فهو سيقلص نفقاته إلى الحد الأدنى خوفا من القادم. وهو ما يعني أن السياحة الوافدة من تلك البلدان سوف تشهد انكماشًا شديدًا في الفترة القادمة. ووضع السياحة الخليجية ليس أفضل كثيرًا فسعر برميل البترول فقد أكثر من نصف قيمته، حيث هبط من140دولار إلى أقل من70دولار للبرميل، وذلك خلال أسابيع، هذا إلى جانب المليارات التي خسرتها دول الخليج النفطية من استثماراتهم في بورصات وأسواق المال الأمريكية والأوروبية. وعلى ذلك، سيكون هناك انخفاضًا حادًا في دخل قطاع السياحة، والقطاعات المرتبطة به.
أما قناة السويس وقد وصلت عائداتها في 2007/2008إلى أكثر من 3.5مليار دولار فهي أيضًا ستتأثر تأثُرًا كبيرًا بسبب الأزمة العالمية، حيث تعتمد عوائدها على حجم حركة شاحنات السلع التي تمر بها، وبما أن هناك انكماشا حادًا في حجم التجارة العالمية، بما فيها البترول، فسوف تشهد الفترة القادمة، بالضرورة، تقلُّصا حادًا في عائدات قناة السويس، وهي المصدر التالي، بعد السياحة، للنقد الأجنبي في مصر.
أما عن الصادرات، فلن تتمكن هي الأخرى من تفادي العاصفة، فالجزء الأكبر من قيمة هذه الصادرات تأتي من تصدير البترول والغاز الطبيعي والتي شهدت أسعارها انخفاضاً حاداً، ولكن حتى الصادرات غير البترولية ستنكمش، بالضرورة، مع انكماش الاستهلاك في الدول المستورِدة الأساسية، وهي أمريكا والاتحاد الأوروبي، ليس بفعل انكماش الطلب فحسب، بل أيضا بسبب المنافسة المحمومة بين دول العام الثالث على هذه الاسواق المنكمشة.
سنواجه إذًا في الفترة القادمة تقلُّصا حادًا في الدخل من الاستثمار الأجنبي والسياحة وقناة السويس والتصدير، وهي كلها مصادر رئيسية للنقد الأجنبي، وذلك في دولة تستورد ما تصل قيمته إلى ضعف قيمة ما تُصدره. أولى النتائج ستكون انخفاضًا حادًا في قيمة الجنيه، الذي فقد بالفعل10%من قيمته أمام الدولار خلال الشهر الماضي، وهو ما يعني أن أسعار السلع الأساسية، وأغلبها يتم استيراده، سوف يرتفع مجددًا، بالرغم من الانخفاض في الأسعار العالمية. وانخفاض قيمة الجنيه يعني أيضًا المزيد من فقدان الثقة لدى المستثمرين المصريين والأجانب في صحة الاقتصاد بشكل عام، وفي استثماراتهم بالجنيه المصري بشكل خاص، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من الضغط على قيمة الجنيه. وهو ما يعني أن التضخم السريع الذي عانينا منه خلال العام الماضي، والذي يصل إلى25%على اقل تقدير، لن يتراجع خلال الفترة القادمة، رغم تأكيدات وتصريحات المسئولين.
النتيجة الثانية لهذه العاصفة ستكون بلا شك زيادة مطّردة في حجم البطالة واتساعها وفي المزيد من الضغط على الأجور. فالرأسمالي الذي لن يتمكن من تحمل العاصفة سيعلن إفلاسه، ويغلق مصانعه وشركاته، ويشرد العاملين بها، والرأسمالي الذي سيتمكن من البقاء، سيقلص من عمال وموظفين شركاته للحد الأدنى، وسيخفض من أجور ومستحقات من يبقيهم إلى الحد الأدنى أيضاً.
تبقى نقطة أخيرة حول قطاع العقارات والذي شهد طفرة غير مسبوقة في الأعوام الأربعة الماضية . ولنضع جانباً الآن غرق هذا القطاع في بحر من فساد السلطة واحتكارات رجالها وكون غالبية مشاريعها موجهة فقط لإسكان وترف الأغنياء في بلد يعيش غالبية سكان مدنه في عشوائيات غير آدمية، ولنركز الآن على كيف سيتأثر هذا القطاع المتضخم بالأزمة العالمية، وكيف سيؤثر ما سيحدث في هذا القطاع على الاقتصاد المصري.
تمثل الطفرة العقارية والزيادة الفلكية في أسعار العقارات نموذجاً آخراً للفقاعات الاقتصادية التي دائمًا ما تخلفها فوضى النظام الرأسمالي. وهذه الفقاعة بخلاف فقاعة سوق العقارات الأمريكية مثلاً ليست نتيجة لتفشي الرهن العقاري والمضاربة على أوراقه (الرهن العقاري في مصر يمثل نسبة ضئيلة من قيمة هذا القطاع في مصر). إن سبب الفقاعة العقارية المصرية يكمن في دخول شركات تنمية عقارية كبرى خليجية ومصرية باستثمارات ضخمة لانشاء مشروعات عقارية عملاقة ( الفطيم وداماك وإعمار من الخليج وطلعت مصطفى وسوديك وبالم هيلز من مصر). كل هذه الشركات حصلت على تسهيلات استثنائية من الحكومة (أسعار أراض تكاد تكون مجانية، إعفاءات ضريبية،... إلخ) وقد ضخت هذه الشركات وغيرها المليارات لبناء مشاريع الإسكان الفاخر حول القاهرة والجيزة وسواحل البحر المتوسط والأحمر. وفي ظل زيادة أسعار العقار أصبح هذا المجال مرتعاً للمضاربين المصريين والأجانب الذين قاموا بشراء الآلاف من هذه العقارات، التي لم يتم إنشاء الكثير منها بعد، ليس بهدف السكن، بالطبع، ولكن للرهان على استمرار ارتفاعها مستقبلاً من أجل بيعها وجني الأرباح.
توشك هذه الفقاعة على الانفجار، فالطلب والاستثمار الخليجي سينكمش بفعل الازمة وانهيار أسعار البترول، وسوف يتسابق المضاربون لبيع عقاراتهم، خوفاً من انهيار الأسعار وستفاجىء شركات التنمية العقارية الكبرى بمشروعاتها تتحول إلى مدن للأشباح، فحجم هذه المشروعات يصل إلى أضعاف مضاعفة من الطلب الحقيقي على مثل هذا النوع من العقارات، وأسعارها لا تمت بصلة للقيمة الحقيقية التي تمثلها، أي قيمة الأرض والبنية التحتية والمنشآت.
إن الأزمة القادمة في هذا القطاع سيكون لها تأثيرًا مبالغاً يضاعف من تأثير العوامل السابقة على الإقتصاد المصري. مرة أخرى سيدفع الثمن العمال والموظفون في شركات الإنشاءات والصناعات المغذية لها( الحديد والأسمنت والخشب، الخ) وسيؤثر أيضاً بشكل سلبي على الشرائح العليا من الطبقة الوسطى التي استثمرت مدخراتها في عقارات ستنهار أسعارها بسرعة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى انكماش الطلب على الصناعات التي تعتمد على استهلاك هذه الشريحة من سيارات وأجهزة كهربائية وغيرها.
إذا وضعنا في الاعتبار كل هذه الضغوط على الاقتصاد المصري، وما يحدث من حولنا بفعل الأزمة العالمية لاقتصادات الدول النامية، او الأسواق الناشئة الأكبر والأقوى، مثل البرازيل والمجر والمكسيك والهند وتركيا، فلنا أن نتوقع ما يلي:
1 – انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري الحقيقي إلى ما يقرب من الصفر، إن لم يكن بالسالب.
2- انخفاض قيمة الجنيه المصري، بكل ما يعنيه ذلك من زيادة في الأسعار، وفقدان الثقة في الاقتصاد.
3- ارتفاع مطرد في نسبة البطالة والتشريد.
4- هجوم شرس من قبل الدولة والرأسماليين على أجور ومكتسبات العمال.
5- عودة الدولة إلى الاعتماد المباشر على مؤسسات التمويل الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي للاقتراض خشية الإفلاس.
7 الطرح الاشتراكي والمستقبل
هيمنت أفكار الليبرالية الجديدة، خلال العقود الثلاث الماضية على السياسات الاقتصادية لغالبية دول العالم سواء المتقدمة أو النامية، وكانت المحاور الأساسية لهذه المدرسة هي تخلي الدولة عن الدور المركزي في الاقتصاد من خلال الخصخصة و التحرير الاقتصادي وضرورة ترك المجال مفتوح أمام حركة رأس المال المالي والانتاجي حول العالم، وما يستلزمه ذلك من تخفيف الرقابة على تلك الحركة.
أخذت الليبرالية الجديدة دفعة كبرى مع انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية ومنظومة وسياسات رأسمالية الدولة فيها، فبدأ الحديث عن "نهاية التاريخ"، وأنه ليس هناك بديلاً للاقتصاد الرأسمالي الحر. وأخذت حكومات العالم الثالث تطبق السياسات الليبرالية الجديدة بشكل ديني خلال الثمانينات والتسعينات، وكانت النتيجة الأساسية لذلك هي تركيز غير مسبوق لرأس المال والثروة في أيدي قلة من رجال الأعمال المحليين في شراكة مع الشركات متعددة الجنسيات، في مقابل الإفقار الشديد للغالبية العظمى من العمال والفلاحين والموظفين والمهمشين.
والنتيجة الثانية كانت، مع ازدياد الاندماج مع السوق العالمية ومع ازدياد الاعتماد على الاستثمار والتمويل الاجنبي والتصدير. أن أصبحت تلك الاقتصادات معرضة لهزات عنيفة، كلما تقلب أو تأزم النظام الرأس مالي العالمي.
لقد ظهر ذلك جلياً في الأزمة المالية الكبرى التي أصابت اقتصادات جنوب شرق آسيا في ١٩٩٧-١٩٩٨، والتي سرعان ما امتدت إلى روسيا وأمريكا الجنوبية. وقد أحدثت تلك الأزمة أول الشروخ في مدرسة الليبرالية الجديدة، وفي هيمنتها العالمية، وبدأت أصوات تتعالى في قلب المؤسسات المالية العالمية تشكك في صحة تلك السياسات، فيما سمي بـ" ما بعد إجماع واشنطن". تلك الأصوات لم تكن اشتراكية بالطبع، فهي لم تشكك في النظام الرأسمالي نفسه، بل دعت إلى درجة أكبر من تدخل الدولة والرقابة على أسواق المال فحسب، أي إلى "ترشيد" الرأسمالية وجعلها أقل عرضة لتلك الهزات العنيفة.
جاء ثاني الشروخ في هيمنة الليبرالية الجديدة مع ظهور ما سمي بـ"حركة مناهضة العولمة الرأسمالية"، سلسلة المظاهرات الجماهرية الضخمة، بدءًا من سياتل في نهايات1999، والتي اجتاحت العديد من مدن العالم، حتى 2004، وقد تزامن ذلك مع ظهور حركات اجتماعية جذرية في أمريكا اللاتينية، معادية لسياسات الليبرالية الجديدة، والتي أوصلت عدد من الأنظمة اليسارية في تلك القارة المشتعلة، إلى الحكم.
ولكن، دون شك، جاء الشرخ الأكبر في منظومة الليبرالية الجديدة وهيمنتها مع الازمة العالمية الحالية ورد فعل كبرى الحكومات الرأسمالية تجاهها، فعمق واتساع الأزمة قد أظهر للجميع أن هناك خللا خطيرا في قلب النظام الرأسمالي، حت أن "آلان جرينسبان" الرئيس السابق للبنك المركزي الأمريكي وأحد مهندسي المنظومة الرأسمالية الأمريكية خلال العقدين الماضيين، قد اعترف مؤخرًا، أمام الكونجرس الأمريكي، أنه غير قادر على استيعاب ما أسماه بـ"التسونامي المالي العالمي".
كان رد فعل الحكومات للأزمة بتأميم البنوك الكبرى، والتدخل واسع النطاق في أسواق المال، أكبر اعتراف بفشل سياسات السوق الحر، وتحول بين يوم وليلة كبار المفكرين الاقتصاديين البرجوازييين من الدفاع الديني عن صنم حرية السوق، إلى دفاع لا يقل حماسا، عن السياسات الكينزية، (نسبة إلى "ماينارد كينز" الاقتصادي البريطاني الذي نادى خلال الثلاثينات بضرورة تدخل الدولة لخلق الطلب في الاقتصاد بعد الكساد العالمي الكبير(1929-1932).
لا تمت السياسات المتبعة اليوم لترشيد الرأسمالية، بالقطع، إلى الاشتراكية فالدولة اليوم تتدخل وتؤمم لإنقاذ الرأسمالية من نفسها وليس لتجاوزها. هذه السياسات والتي اسماها الاقتصادي الماركسي الكبير سمير أمين "بتأميم الخسائر وخصخصة الأرباح"، سوف يدفع ثمنها عمال وفقراء العالم، وليس أثريائها. ولكن على الرغم من ذلك، فهي تمثل فرصة تاريخية لصعود جديد لليسار الاشتراكي على مستوى الفكر والتحليل من جانب، وعلى مستوى الممارسة والنضال من جانب آخر، فهناك شرخًا عميقًا يصعب ترميمه في جدران الرأسمالية العالمية، وفي هيمنة منظومتها الفكرية والدعائية.
هناك فرصة تاريخية لطرح البديل الاشتراكي ذلك البديل الذي يريد نظاماً جديداً للإنتاج يكون هدفه تلبية حاجات البشر وليس الربح. نظاماً قائماً على التخطيط الديمقراطي لعملية الانتاج والتوزيع والاستهلاك وليس على فوضى السوق والتنافس والذي لا ينتج إلا الإهدار والأزمة والفقر للغالبية. نظاماً قائماً على المساواة بين البشر وليس تراكم المليارات (بالدولار) في أيدي قلة صغيرة من المحتكرين في حين يجوع مليارات (من البشر). نظاماً قائماً على الملكية العامة لوسائل الإنتاج تحت السيطرة الديمقراطية للعمال وليس على الملكية الخاصة والتي ظلوا يدافعون عن مزاياها في زيادة الانتاج والكفائة ولم نرى منها أبداً سوا الاحتكار والنهب والتداخل بين المال والسلطة. أما عن الكفائة فيكفينا أن ننظر للتريليونات التي تتبخر اليوم في ظل الأزمة المالية وإلى الماكينات التي ستتعطل والسلع المنتجة