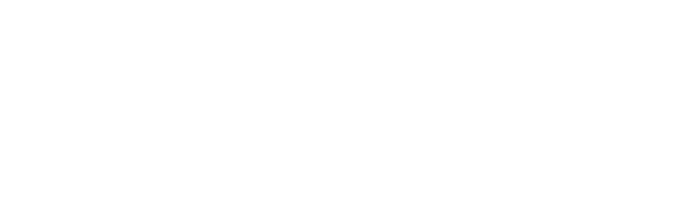الكارثة الاقتصادية العالمية.. رؤية إسلامية
د. أحمد بلوافي
* أكاديمي جزائري .. مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
جامعة الملك عبد العزيز -جدة.
المختصر
لا تزال تبعات الأزمة المالية العالمية وآثارها تلقي بظلالها على جميع
الأصعدة والقطاعات والدول. ففي كل يوم نقرأ ونسمع أن الأزمة عميقة، وعميقة
جداً وأن الحلول التي تقدم لعلاجها ليست كافية، فضخ 700 أو 800 مليار أو
حتى تريليون (1000 مليار) دولار، وتخفيض معدلات الفوائد الأساسية الاسمية
إلى الصفر أو قريب منه، لن تنتشل العالم المتقدم ومن ورائه العالم
"الصاعد" و"النامي" مما هو فيه، ولن تجنبه ركوداً اقتصادياً حاداً هذا
العام (2009م) ، ولن تعيد له الثقة بالدرجة التي يطمح إليها، والأهم من
ذلك لن تؤدي إلى إصلاح النظام الذي كان مصدراً لهذه الكارثة.
إن الحلول المقدمة لعلاج هذه الأزمات ينطبق عليها إلى حد كبير قول القائل
:"وداوني بالتي كانت هي الداء"، وهذا ليس من قبيل الرجم بالغيب بقدر ما هو
استنتاج واستخلاص طبيعي متأن من دروس هذه الأزمات المتلاحقة وطرق تشخيصها
ثم علاجها،
لأن الذين يرسمون السياسات المالية والاقتصادية والذين يُنظِّرون لهم
يدورون في حلقة مفرغة حول ما أنتجوه من أفكار ونظريات سلموا بها، ولم
يريدوا مناقشة منطلقاتها وأساسياتها إلا من خلال المنظومة الفكرية وفي
إطارها الضيق للنظام وليس من خارجها، ولهذا يجد العالم نفسه أمام حزمة من
الإجراءات لا تخرج عن العلاج "الكينزي"،
كما هو حاصل هذه الأيام، في حال تعثر فلسفة وسياسة "دعه يعمل (Laissez-faire)"، أو العلاج الليبرالي في حال تعثر البرنامج الكينزي.
ومن أمثلة هذا العلاج ضخ أموال عامة من خلال التحفيز المالي (Fiscal
stimulus) لزيادة الطلب لبعث الحركة في الاقتصاد من جديد؛ بالإنفاق
للاستهلاك وغيره، مما يؤدي إلى دفع عجلة الاستثمار والإنتاج فالتشغيل،
وهكذا إلى أن تسترد الدورة الاقتصادية عافيتها وتسير عجلة الاقتصاد بسلاسة
واتزان!.
إن تراكم ديون الربا من خلال ضخ الأموال العامة أو غيرها تقود إلى نتيجتين
حتميتين منطقيتين لا ثالث لهما، ذكرهما الإمام الجليل ابن قيم الجوزية في
إعلام الموقعين قبل أكثر من سبعمائة سنة ، وهما:
1. دفع أموال الربا من وقت لآخر، بالوسائل المختلفة لا تخرج عن مغزى
وحقيقة "زدني وأربِ"، أي زدني في مدة السداد وأضف أموال الربا (وعادة ما
تكون النسب فيه مضاعفة) مقابل ذلك، سواء كان ذلك من خلال بطاقات الائتمان
كما حصل في الأزمة الأخيرة، عندما عجز كثير ممن استدانوا لشراء المنازل في
أمريكا عن دفع ما عليهم من مستحقات،
فلجئوا بشكل كبير إلى مزيد من الاستدانة من خلال البطاقات البلاستيكية ذات
الأثر المغري لسهولة الاستخدام أو غيرها، أو كما حصل ويحصل للعديد من
الدول النامية عندما تعجز عن الوفاء بديونها، فتجد نفسها مضطرة إلى إعادة
جدولة ديونها (Rescheduling of Debts)، من خلال نادي باريس (Paris Club)
للحكومات الدائنة، أو نادي لندن (London Club) للبنوك الخاصة الدائنة.
والمحصلة من كل ذلك تراكم أموال الربا أضعافاً مضاعفة.
2
. استغراق جميع موجودات المدين كالسكنى وغيرها، وهذا الذي يعيش العالم تحت
وطأته، وذلك لأن قيم الموجودات المالية التي نمت وتفاقمت بفعل الربا
والميسر تفوق وبنسب كبيرة قيم الأصول الحقيقية للاقتصاد العالمي، فعلى
سبيل المثال القيمة الخيالية ((Notional Value للمشتقات المالية التي كانت
السبب في تفاقم وانتشار أزمة الرهن العقاري في أمريكا تبلغ أكثر من 600
تريليون دولار في حين أن الإنتاج العالمي تقدر قيمته بـ 60 تريليون دولار
(أي نسبة 10 إلى 1)،
فإذا أريد تحويل تلك المبالغ الخيالية المالية إلى أصول حقيقية كم سيتطلب
من العالم من سنة لإنتاج ما يفي بذلك؟ فلو فرضنا نسبة نمو متوسطة سنوية
للاقتصاد العالمي بـمقدار5%، فإن هذا يعني أن دفع تلك المبالغ مع افتراض
إيقاف تراكم غيرها كالفوائد الربوية سيتطلب من العالم تخصيص إنتاج 47.2
سنة!!،
نعم أكثر من 47 سنة للوفاء بقيمة هذه الأصول الخيالية لا غير. هذا كما
ذكرنا في حال تحقيق نسبة النمو المفترضة ومع التوقف التام عن الاقتراض،
أما على أرض الواقع فإن الأمر مختلف جداً لأنه لا يمكن بحال ضمان تحقيق
تلك النسبة كما لا يمكن التوقف عن الاقتراض لأنه محرك رئيس لعجلة
الاقتصادات المعاصرة (Credit Driven Economies)، مما يعني الاستمرار أكثر
من خمسين عاماً للتخلص من قيم تلك الأموال.
إنها فعلاً أمور محيرة تصيب الإنسان بالدوار ، وتجعل من الفلسفة
الاقتصادية القائمة أمراً غير مستساغ منطقاً وواقعاً. وهو ما يفسر تبخر
آلاف الملايين من الدولارات ومع ذلك نجد أرباب النظام والمنظرين له لا
يقفون وقفة جادة في مراجعة الأسس والمنطلقات، بل يتمادون في فرض منطقهم
باقتراح وسائل وآليات تكافئ المتسبب، وتعاقب المتضرر،
ولا ينقضي عجب الإنسان عندما يطلع على تقارير ودراسات أو يقف على تصريحات
للقائمين على مؤسسات مالية كبيرة كصندوق النقد الدولي، حين يقرر مديره
العام أن دولاراً ننفقه لإنقاذ المصارف أنفع وأجدى لتحقيق الخروج أو
"الشفاء" (Recovery) من الأزمة من إنفاقه في الطرقات والمستشفيات وغيرها
من المرافق العمومية،
ويؤكد في الوقت ذاته على ضرورة تصغير أحجام (Downsizing) البنوك المتأثرة
بالأزمة لأن عملية ضخ رؤوس أموال عامة فيها والاعتراف بالخسائر التي لحقت
بها ليس كافياً ، أو عندما يقترح خبراؤه تخصيص "بنك للقروض الرديئة" من
بين البنوك المملوكة للدولة حتى يخلص الميزانيات العمومية للمؤسسات
المعنية [التي تسببت في الكارثة] من الأصول المتعثرة [القروض التي عجز
المدينون عن سدادها] ،
والتي تمثل جزءاً من الخسائر الناجمة عن الأزمات والتي باتت تعرف في
الأدبيات المالية والاقتصادية بالأصول السامة (Toxic Assets)، والتي يجب
أن يتخلص منها بشكل كامل حتى يسترد الاقتصاد العالمي عافيته، وهذا ما خلص
إليه صندوق النقد الدولي كما يقرر مدير صندوق النقد الدولي (26/1/2009م)،
بعد تجربة مريرة مع 122 أزمة. فأي منطق هذا الذي يسود العالم؟ وأي فلسفة
اقتصادية هذه التي يتمادى أصحابها في اتباعها؟
إن هذه الفلسفة الاقتصادية والسياسات المالية والاقتصادية المتناقضة التي
أنتجتها حولت العالم برمته من منتج للسلع والخدمات بشكل رئيس إلى منتج
للديون بدون منازع، وخاصة الولايات المتحدة، وقد انتشرت هذه الديون التي
تمثل المصدر الرئيس للأصول "السامة" كالسرطان في جسد الاقتصاد العالمي،
ولن يقف في وجه المزيد من انتشارها إلا وضع حد للربا وللأموال التي يولدها
بشكل غير طبيعي؛ أي الفوائد المترتبة على القروض.
وقد اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن يكون وضع أموال الربا من أواخر الإجراءات التي قررها الشرع الحنيف
عندما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بوضع أموال الربا،
وأول مال وضعه في ذلك هو مال عمه العباس بن عبد المطلب-رضي الله عنه- (
(
وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا
عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ)) [مسلم
3009].
وقد وضع ذلك الإجراء مع غيره حداً لتراكم الأموال الربوية التي لو استمر
أمرها لتعرض الاقتصاد لهزات وهزات وتقلبات حادة تخرج الوضع عن السيطرة،
وهو ما نعايشه من خلال الأزمات المتلاحقة حيث ظل العالم وسيظل يكابد "وضع"
تلك الأموال وأصولها، بل والكثير من المشاريع والإنجازات الأخرى بالطريق
القسري من خلال هذه الأزمات، والتي سيتفاقم أمرها إذا لم يُعد النظر في
الفلسفة والنظريات الاقتصادية التي تقود العالم اليوم، لأن الكارثة
والانهيار هي النهاية الحتمية لذلك.
فهل يعي من يهمه الأمر خطورة الوضع؟ أم أن سياسة المضي للأمام مهما
كان حجم التكاليف والآثار ستبقى سيدة الموقف لترث الأجيال القادمة تركة
يصعب إدراك حقيقة "ألغاز" خيوطها وملابسات تعقيداتها ناهيك عن التوصل لحل
يضع حداً لآثارها وتبعاتها؟!

د. أحمد بلوافي
* أكاديمي جزائري .. مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
جامعة الملك عبد العزيز -جدة.
المختصر
لا تزال تبعات الأزمة المالية العالمية وآثارها تلقي بظلالها على جميع
الأصعدة والقطاعات والدول. ففي كل يوم نقرأ ونسمع أن الأزمة عميقة، وعميقة
جداً وأن الحلول التي تقدم لعلاجها ليست كافية، فضخ 700 أو 800 مليار أو
حتى تريليون (1000 مليار) دولار، وتخفيض معدلات الفوائد الأساسية الاسمية
إلى الصفر أو قريب منه، لن تنتشل العالم المتقدم ومن ورائه العالم
"الصاعد" و"النامي" مما هو فيه، ولن تجنبه ركوداً اقتصادياً حاداً هذا
العام (2009م) ، ولن تعيد له الثقة بالدرجة التي يطمح إليها، والأهم من
ذلك لن تؤدي إلى إصلاح النظام الذي كان مصدراً لهذه الكارثة.
إن الحلول المقدمة لعلاج هذه الأزمات ينطبق عليها إلى حد كبير قول القائل
:"وداوني بالتي كانت هي الداء"، وهذا ليس من قبيل الرجم بالغيب بقدر ما هو
استنتاج واستخلاص طبيعي متأن من دروس هذه الأزمات المتلاحقة وطرق تشخيصها
ثم علاجها،
لأن الذين يرسمون السياسات المالية والاقتصادية والذين يُنظِّرون لهم
يدورون في حلقة مفرغة حول ما أنتجوه من أفكار ونظريات سلموا بها، ولم
يريدوا مناقشة منطلقاتها وأساسياتها إلا من خلال المنظومة الفكرية وفي
إطارها الضيق للنظام وليس من خارجها، ولهذا يجد العالم نفسه أمام حزمة من
الإجراءات لا تخرج عن العلاج "الكينزي"،
كما هو حاصل هذه الأيام، في حال تعثر فلسفة وسياسة "دعه يعمل (Laissez-faire)"، أو العلاج الليبرالي في حال تعثر البرنامج الكينزي.
ومن أمثلة هذا العلاج ضخ أموال عامة من خلال التحفيز المالي (Fiscal
stimulus) لزيادة الطلب لبعث الحركة في الاقتصاد من جديد؛ بالإنفاق
للاستهلاك وغيره، مما يؤدي إلى دفع عجلة الاستثمار والإنتاج فالتشغيل،
وهكذا إلى أن تسترد الدورة الاقتصادية عافيتها وتسير عجلة الاقتصاد بسلاسة
واتزان!.
إن تراكم ديون الربا من خلال ضخ الأموال العامة أو غيرها تقود إلى نتيجتين
حتميتين منطقيتين لا ثالث لهما، ذكرهما الإمام الجليل ابن قيم الجوزية في
إعلام الموقعين قبل أكثر من سبعمائة سنة ، وهما:
1. دفع أموال الربا من وقت لآخر، بالوسائل المختلفة لا تخرج عن مغزى
وحقيقة "زدني وأربِ"، أي زدني في مدة السداد وأضف أموال الربا (وعادة ما
تكون النسب فيه مضاعفة) مقابل ذلك، سواء كان ذلك من خلال بطاقات الائتمان
كما حصل في الأزمة الأخيرة، عندما عجز كثير ممن استدانوا لشراء المنازل في
أمريكا عن دفع ما عليهم من مستحقات،
فلجئوا بشكل كبير إلى مزيد من الاستدانة من خلال البطاقات البلاستيكية ذات
الأثر المغري لسهولة الاستخدام أو غيرها، أو كما حصل ويحصل للعديد من
الدول النامية عندما تعجز عن الوفاء بديونها، فتجد نفسها مضطرة إلى إعادة
جدولة ديونها (Rescheduling of Debts)، من خلال نادي باريس (Paris Club)
للحكومات الدائنة، أو نادي لندن (London Club) للبنوك الخاصة الدائنة.
والمحصلة من كل ذلك تراكم أموال الربا أضعافاً مضاعفة.
2
. استغراق جميع موجودات المدين كالسكنى وغيرها، وهذا الذي يعيش العالم تحت
وطأته، وذلك لأن قيم الموجودات المالية التي نمت وتفاقمت بفعل الربا
والميسر تفوق وبنسب كبيرة قيم الأصول الحقيقية للاقتصاد العالمي، فعلى
سبيل المثال القيمة الخيالية ((Notional Value للمشتقات المالية التي كانت
السبب في تفاقم وانتشار أزمة الرهن العقاري في أمريكا تبلغ أكثر من 600
تريليون دولار في حين أن الإنتاج العالمي تقدر قيمته بـ 60 تريليون دولار
(أي نسبة 10 إلى 1)،
فإذا أريد تحويل تلك المبالغ الخيالية المالية إلى أصول حقيقية كم سيتطلب
من العالم من سنة لإنتاج ما يفي بذلك؟ فلو فرضنا نسبة نمو متوسطة سنوية
للاقتصاد العالمي بـمقدار5%، فإن هذا يعني أن دفع تلك المبالغ مع افتراض
إيقاف تراكم غيرها كالفوائد الربوية سيتطلب من العالم تخصيص إنتاج 47.2
سنة!!،
نعم أكثر من 47 سنة للوفاء بقيمة هذه الأصول الخيالية لا غير. هذا كما
ذكرنا في حال تحقيق نسبة النمو المفترضة ومع التوقف التام عن الاقتراض،
أما على أرض الواقع فإن الأمر مختلف جداً لأنه لا يمكن بحال ضمان تحقيق
تلك النسبة كما لا يمكن التوقف عن الاقتراض لأنه محرك رئيس لعجلة
الاقتصادات المعاصرة (Credit Driven Economies)، مما يعني الاستمرار أكثر
من خمسين عاماً للتخلص من قيم تلك الأموال.
إنها فعلاً أمور محيرة تصيب الإنسان بالدوار ، وتجعل من الفلسفة
الاقتصادية القائمة أمراً غير مستساغ منطقاً وواقعاً. وهو ما يفسر تبخر
آلاف الملايين من الدولارات ومع ذلك نجد أرباب النظام والمنظرين له لا
يقفون وقفة جادة في مراجعة الأسس والمنطلقات، بل يتمادون في فرض منطقهم
باقتراح وسائل وآليات تكافئ المتسبب، وتعاقب المتضرر،
ولا ينقضي عجب الإنسان عندما يطلع على تقارير ودراسات أو يقف على تصريحات
للقائمين على مؤسسات مالية كبيرة كصندوق النقد الدولي، حين يقرر مديره
العام أن دولاراً ننفقه لإنقاذ المصارف أنفع وأجدى لتحقيق الخروج أو
"الشفاء" (Recovery) من الأزمة من إنفاقه في الطرقات والمستشفيات وغيرها
من المرافق العمومية،
ويؤكد في الوقت ذاته على ضرورة تصغير أحجام (Downsizing) البنوك المتأثرة
بالأزمة لأن عملية ضخ رؤوس أموال عامة فيها والاعتراف بالخسائر التي لحقت
بها ليس كافياً ، أو عندما يقترح خبراؤه تخصيص "بنك للقروض الرديئة" من
بين البنوك المملوكة للدولة حتى يخلص الميزانيات العمومية للمؤسسات
المعنية [التي تسببت في الكارثة] من الأصول المتعثرة [القروض التي عجز
المدينون عن سدادها] ،
والتي تمثل جزءاً من الخسائر الناجمة عن الأزمات والتي باتت تعرف في
الأدبيات المالية والاقتصادية بالأصول السامة (Toxic Assets)، والتي يجب
أن يتخلص منها بشكل كامل حتى يسترد الاقتصاد العالمي عافيته، وهذا ما خلص
إليه صندوق النقد الدولي كما يقرر مدير صندوق النقد الدولي (26/1/2009م)،
بعد تجربة مريرة مع 122 أزمة. فأي منطق هذا الذي يسود العالم؟ وأي فلسفة
اقتصادية هذه التي يتمادى أصحابها في اتباعها؟
إن هذه الفلسفة الاقتصادية والسياسات المالية والاقتصادية المتناقضة التي
أنتجتها حولت العالم برمته من منتج للسلع والخدمات بشكل رئيس إلى منتج
للديون بدون منازع، وخاصة الولايات المتحدة، وقد انتشرت هذه الديون التي
تمثل المصدر الرئيس للأصول "السامة" كالسرطان في جسد الاقتصاد العالمي،
ولن يقف في وجه المزيد من انتشارها إلا وضع حد للربا وللأموال التي يولدها
بشكل غير طبيعي؛ أي الفوائد المترتبة على القروض.
وقد اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن يكون وضع أموال الربا من أواخر الإجراءات التي قررها الشرع الحنيف
عندما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بوضع أموال الربا،
وأول مال وضعه في ذلك هو مال عمه العباس بن عبد المطلب-رضي الله عنه-
 (
(وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا
عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ)) [مسلم
3009].
وقد وضع ذلك الإجراء مع غيره حداً لتراكم الأموال الربوية التي لو استمر
أمرها لتعرض الاقتصاد لهزات وهزات وتقلبات حادة تخرج الوضع عن السيطرة،
وهو ما نعايشه من خلال الأزمات المتلاحقة حيث ظل العالم وسيظل يكابد "وضع"
تلك الأموال وأصولها، بل والكثير من المشاريع والإنجازات الأخرى بالطريق
القسري من خلال هذه الأزمات، والتي سيتفاقم أمرها إذا لم يُعد النظر في
الفلسفة والنظريات الاقتصادية التي تقود العالم اليوم، لأن الكارثة
والانهيار هي النهاية الحتمية لذلك.
فهل يعي من يهمه الأمر خطورة الوضع؟ أم أن سياسة المضي للأمام مهما
كان حجم التكاليف والآثار ستبقى سيدة الموقف لترث الأجيال القادمة تركة
يصعب إدراك حقيقة "ألغاز" خيوطها وملابسات تعقيداتها ناهيك عن التوصل لحل
يضع حداً لآثارها وتبعاتها؟!